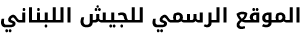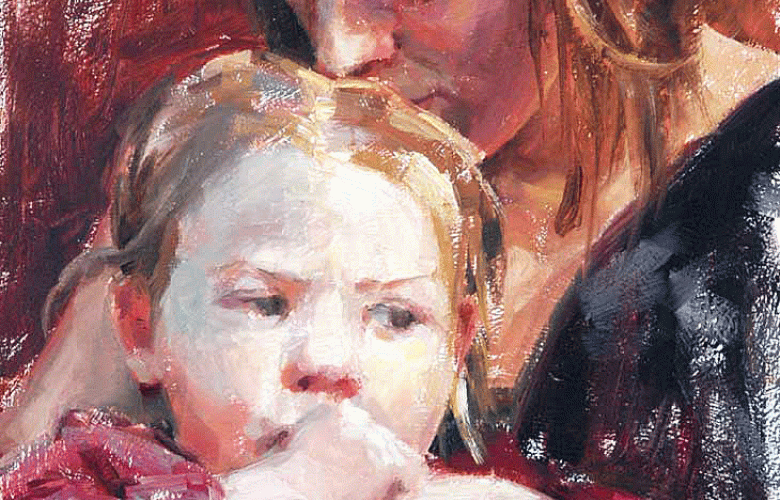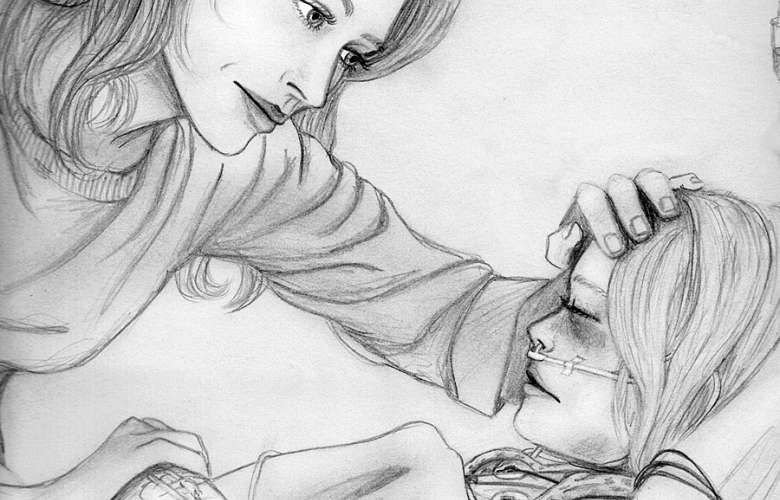- En
- Fr
- عربي
قصة قصيرة
قالت لها صاحبتها ذات يوم: «أتعرفين يا رازان؟ الناس كلّهم يتحدّثون عن طبيب في المدينة يجري عمليات استئصال كِلى مقابل مبالغ مالية كبيرة».
- أجل. المرضى الأغنياء يدفعون لشراء صحّتهم ولا يسألون. أما الفقراء أمثالنا فإنهم يموتون ولا تتوافر لهم حبّة دواء. هكذا أجابت رازان، وتنهّدت بمرارة.
- لا يا غشيمة. ليس المرضى مَن تُجرى لهم العمليات، بل الأصحّاء مثلي ومثلك. ويدفع لهم الطبيب عن كلّ كلية يشتريها منهم ثمنًا باهظًا... هو قال إن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ولعمر طويل. والطبيب لا أراه يكذب على الناس.
«الأصحّاء مثلي ومثلك». عبارة قصيرة راحت رازان تفكّر فيها وتفكّر. إنها أرملة فقيرة ترك لها زوجها أربعة صبيان وثلاث بنات قاصرين، عليها أن تؤمّن لهم المأكل، والمَلبس، والدواء، وكلّ حاجات الحياة. صحيح أنها تعمل في البيوت كلّ يوم من الصباح حتى المساء، لكن أجرها يكاد لا يكفي لدفع إيجار البيت الصغير وثمن رغيف الخبز. ومَن يدري إلى متى يستطيع هذا الجسد أن يصمد ويكافح. فلماذا إذاً لا تبيع كلية من كليتَيها، وتقبض الكثير من المال، وتعيش وأولادها في بحبوحة مثل الناس؟ إنها تثق بكلام صاحبتها وتصدّقها. هي لا تكذب عليها، وفي هذه المسائل تعرف أكثر منها. إلا أنها سرعان ما استفاقت من حلمها، وقالت: «ولكن القانون يعاقب على مثل هذه الأعمال، أليس كذلك؟». فارتسمت على ثغر صاحبتها ابتسامة ساخرة: «أوتعتقدين أن الطبيب غير متفاهم مع رجال القانون!؟ إطمئنّي يا صديقتي؛ فالقانون في هذه البلاد يميّز الكبار، ويغضّ الطرْف عنهم».
هكذا قالت المرأة، ونهضت، وانصرفت تاركة صديقتها في حيرة وضياع، فكرة تحملها إلى عالم جميل، وفكرة تردّها إلى الواقع المرير. ثم صمّمت على الأمر. لكنها عادت وتراجعت عنه بعدما رأت نفسها بعين خيالها ممدّدة على ظهرها في غرفة العمليات، مشقوقة الخاصرة تنزف، والطبيب إلى جانبها يهزّ رأسه عاقد الحاجبَين، والممرّضات من حولها واجمات. ولكن عندما دخلت المطبخ ووجدت أن أصنافًا كثيرة من المؤونة فيه قد نفدت أو كادت ثم سمعت أولادها يطلبون العشاء بإلحاح الجائع، عقدت العزم على المضيّ قُدُمًا من غير تردّد. وطردت الأفكار السود من رأسها. واستبدلتها بصوَر جميلة أعادت الحياة إلى نفسها الميتة.
وكان صباح قصدت فيه رازان صاحبتها. وطلبت منها أن تدبّر لها موعدًا مع الطبيب لتتحدّث إليه؛ فنزلت المرأة عند رغبتها وشجّعتها. وفي اليوم المحدّد التقتها في محطّة القطارات. واصطحبتها إلى عيادة الطبيب في ذاك المستشفى الصغير. وهناك فحص الطبيب رازان، و«دقّ على الخشب». وأكّد لها أن كلّ شيء سيكون على ما يُرام. ووعدها بمبلغ كبير من المال جعل قلبها يرقص فرحًا وعينيها تريان الحياة بلون جديد.
في اليوم التالي ودّعت المرأة أولادها. قالت لهم إنها قاصدة المدينة لإجراء بعض الفحوصات الطبّية، وربما بقيت في المستشفى لبضعة أيّام. ثم خرجت تحمل بيدها حقيبة ملابس عتيقة، وبقلبها أمنيات كثيرة. وبعد ساعة مسير على القدمَين، وجدت نفسها في القطار مرّة ثانية وإلى جانبها صديقتها تقوّي من عزيمتها، وتشدّ على يدها كلّما آنست منها خوفًا أو تردّدًا. وعندما وصلتا إلى المستشفى استقبلهما الطبيب بابتساماته ولطيف كلماته قبل أن يأتي مَن يحقن المرأة بالمخدّر ويقودها إلى غرفة العمليات، هذه الغرفة التي سرعان ما دخلها الطبيب بعدما أجرى مع صديقة رازان حديثاً قصيرًا، ثم دسّ في جيبها بضع أوراق نقدية أثلجت قلبها ورسمت الضحكة على ثغرها.
وبعد مضيّ وقت غير قصير فُتح الباب، واقتيدت رازان على عربة إلى الطابق العلويّ. وعندما فتحت عينيها رأت رفيقتها إلى جانب سريرها تبتسم لها وتمسك بيدها.
- الحمد لله على السلامة. كلّ شيء بخير. قالت المرأة.
- كم عليّ أن أبقى هنا؟ سألت رازان، وقد أضفى شحوب ما بعد العملية على وجهها المستدير مسحة جديدة من البراءة والجمال.
- أربعة أيّام، قال الطبيب.
وانقضت الأيّام الأربعة بطيئة جدًّا. وفي صباح الخامس استقبل الطبيب الصديقتَين في عيادته. ودفع إلى رازان بكيس صغير فتحته، وأخذت تعدّ الأوراق التي فيه. لكنها ما لبثت أن نظرت إلى الطبيب مقطّبة الجبين مستاءة: «ليس هذا ما وعدتني به يا دكتور».
- تبيّن في الكلية عيب بسيط سيحول، من غير شكّ، دون بيعها بالسعر المطلوب.
- ماذا... تقصد... بالعيب يا دكتور؟ سألت تمتمةً، والخوف من الجواب يعقل لسانها.
- لا تخافي. مجرّد التواء. أما الثانية فسليمة تمامًا.
- لكن هذا مبلغ قليل جدًّا.
- احمدي الله، واشكري الدكتور. قالت المرأة، وأردفت: إنه يعرّض نفسه ومهنته للخطر من أجل مساعدة الناس المحتاجين... هيّا. خذي المال، ولنعُدْ إلى البيت.
عصرت رازان كيس النقود ببطء في كفّها. وأغمضت عينيها على دمعتين حارقتين. ثم استدارت، وفتحت الباب، وخرجت مسحوقة الفؤاد مهزومة النفس. وعادت إلى بيتها تحضن أولادها، وتتعب في سبيلهم، وتبكي في الخفاء فلا تدعهم يبصرون دموعها. لكن العمل في بيوت الناس بكلية واحدة أرهقها، ثم هدّ جسمها وأقعدها؛ فراحت المسكينة تصرف من المال المدّخَر، والكيس يصغر حجمه ويخفّ وزنه يومًا بعد يوم لأن ما يخرج منه لا يعود إليه. لكنها شكرت الربّ لأنها تعافت، وعادت إلى العمل في ما تقدر عليه، حتى حدث ما لم يكن في الحسبان ولا خاطرًا في البال.
ما حدث هو أن ابنها الأصغر كونار أخذ جسمه يضعف، ونشاطه يتلاشى، ولونه يميل إلى الاصفرار. إذا مشى خطوتين، تعب وجلس يرتاح. وإذا نام ليلاً، نهض صباحًا والعرق يغسل جسمه وثيابه.
شغلت حال ابن الثمانية بال الأمّ وأقضّت مضجعها؛ فاستشارت جاراتها وكبار السنّ في قريتها، لكن وصفاتهم ما قدّمت ولا أخّرت. أخذته إلى طبيب سمعت به في مدينة قريبة؛ ففحصه، ووصف له أدوية كثيرة اشترتها أمّه بأثمان غالية، لكنها لم تنفعه. جرّب له غيرها والنتيجة هي هي. ولما ازداد وضعه سوءًا، نقلته أمّه إلى أكبر مستشفى في العاصمة؛ فأُجريت له التحاليل المخبرية، والصوَر الشعاعية. وانكشفت العلّة الدفينة.
- لا أخفي عنكِ أن ابنك يعاني مشكلة كبيرة. قال كبير الأطبّاء.
- ما الأمر يا دكتور؟ قل لي أرجوك. إنك تخيفني بهذا الكلام.
- كليتاه تعملان بمشقّة بالغة. أخشى أن تتوقّفا كليًا عن العمل بعد مدّة قصيرة.
إذّاك ارتمت الأمّ على ركبتَيها أمام الطبيب تبكي بمرارة: «أستحلفك بأعزّ ما تملك أن تفعل شيئًا لإنقاذه، أرجوك».
- تحلّي بالصبر يا أختي. واتّكلي على الربّ.
واتّكلت الأمّ على الربّ. ودأبت على الصلاة كلّ صباح ومساء. وحال الصبيّ ظلّت تؤول من سيّء إلى أسوأ. لكن الأمّ بقيت تعلّل نفسها بالأمل، حتى كانت مرّة نظر فيها الطبيب إليها نظرة حزينة، ووضع يده على كتفها، وقال: «إني آسف جدًّا. لقد وقع ما كنت أخشاه. علينا من الآن فصاعدًا أن نجري له جلسات تنقية دم».
- ماذا!؟ قالتها الأمّ بكاءً، وأضافت: أما هناك من حلّ بديل؟
- بلى. بإمكاننا أن نزرع له كلية إذا توافرت ولاءمت جسمه.
- أرجوك يا دكتور. إفعل ما هو مناسب. هكذا قالت، وفتحت كيس نقودها مبغوتة: «أنظر. لديّ المال اللازم لكلّ ما يتوجّب عمله». وإذ ألقى الطبيب نظرة خاطفة على ما في يديها، ابتسم إشفاقًا: «ردّي مالك إلى مكانه يا أختي. أتعتقدين أنك بهذه الدراهم القليلة تستطيعين أن تشتري كلية لابنك؟».
- أهبُه كليتي يا دكتور. ألا أستطيع؟
- بلى إن كانت تلائمه.
- إنها سليمة. أنا أعرف ذلك. خذها، وازرعها في جسمه، أرجوك.
- حسناً. إنه حلّ معقول.
ولكن عندما همّ الطبيب بفحصها وكشف عن خاصرتها، سألها عن أثر ذلك الجرح الذي فيها؛ فأخبرته كلّ حكايتها. عندئذٍ تفرّس في عينيها بصمت باحثًا عن أيّ علامة جنون فيهما، ثم قال منزعجًا: قومي من هنا. أنا طبيب جرّاح لا جزّار.
- ما قيمة حياتي يا دكتور لو مات ابني؟
لكن الطبيب خرج من غير أن يلتفت إلى الوراء؛ فخرجت المرأة من بعده. وعادت إلى غرفة ابنها؛ فبدا لها على سرير المعاناة زهرة نديّة تكاد الريح أن تقصف ساقها. وإذ ابتسم لها، مدّت له يدها وابتسمت، لكنّ دمعتين حارّتين سقطتا من عينيها غصبًا عنها.
- لماذا تبكين يا أمّي؟ سأل كونار.
- سيكون كلّ شيء بخير يا ولدي. إني أعدك بذلك.
لكنها حين وعدتْه لم تكن تعرف أنها لن تستطيع البرّ بالوعد. لم تكن تعرف أن الخير في الأرض قد نضب وجفّت ينابيعه. قصدت الأثرياء الذين أصابت التخمة بطونهم كما جيوبهم، والوجهاء الذين يتصدّرون المجالس في كلّ مناسبة؛ فحلفوا بالأيمان المعظّمة أن أيّامهم قد ولّت ومواسم عزّهم أجدبت. لجأت إلى الجمعيّات الخيرية، فلم تجد عندها ما يُسمن ويُغني من جوع. إذّاك عادت إلى ابنها خالية الوفاض مهزومة النفس، فوجدته نظير زهرة ذابلة تغالب العطش والعطش يغلبها. اسودّت الدنيا أمام ناظريها وتسرّبت الظلمة حتى أعماق قلبها؛ فخرجت إلى الممرّ تذرعه جيئةً وذهابًا وهي تنظر إلى الأرض وتفكّر. كانت تفكّر إن كان باستطاعة الإنسان أن يرسم قدره بنفسه أم أن للقدر خطًا مرسومًا منذ البدء، ولا شيء يغيّره أو يمحوه. وتفكّر في الحياة التي قد تجد راحتها في أحضان الموت، والموت الذي قد ينقذ الحياة.
وأخيرًا تقدّمت نحو آخر الممرّ بخطوات واسعة، وأطلّت برأسها من نافذة الطابق السادس؛ فرأت الساحة أمام مدخل المستشفى بعيدة جدًّا. أغمضت عينيها، وجمدت للحظة، ثم استدارت، وانتحت ناحيةً جلست فيها. وأخرجت ورقة كتبت عليها أسطرًا قليلة. ودخلت غرفة ابنها. وجلست بمحاذاة سريره. وبكت فوق صدره كثيرًا. واستغفرت الله طويلاً. ثم خرجت إلى الممرّ، ومشت حتى آخره. وأخذت تبكي بصوت عالٍ لتلفت الأنظار إليها. ولما تجمهر الناس والممرّضات حولها، ألقت بنفسها من النافذة العالية.
فزع الناس والمسعفون إلى المرأة؛ فألْفوها جثّة هامدة لا حياة فيها. ووجدوا في يدها ورقة مطويّة فتحها أحد رجال الإسعاف، وقرأ: «يا مَن هرعتم إليّ ملهوفين آسفين. إذا وجدتم فيّ بعدُ بقيّة حياة، أرجوكم ألا تفعلوا شيئًا لإنقاذي، بل دعوني أموت برضى وسلام حتى يتسنّى للأطبّاء نزع كليتي وزرعها في جسد ابني ليعيش من بعدي. ها إني، في هذه الكلمات، أوصي بها إليه، كما أوصي بما في جسدي الفاني من أعضاء سليمة إلى محتاجيها في هذا المستشفى أوّلاً وفي غيره من بعده».
وفي الحال نفّذت إدارة المستشفى الوصيّة. وأمرت باستئصال كلية المرأة لصالح ابنها. ووهبت العينَين لأعميين ينتظران منذ زمن بعيد؛ فأبصرا كلٌّ بعين واحدة، ورفعا للمرأة الأدعية بالرحمة ولأولادها بالسلامة والعمر الطويل.
أما في تلك القرية الصغيرة، فأقيم مأتم قلّ نظيره شارك فيه كلّ أبناء الجوار. وخلف النعش المطمور بالزهور البيض مشى الناس، وأولاد المرأة، والأعميان اللذان أبصرا، وبكى الأقربون والأبعدون. وأما كونار فتماثل إلى الشفاء. وخرج من المستشفى. ودأب على زيارة ضريح أمّه مرّة كلّ سنة في ذكرى موتها، ومحادثتها، وترْك باقة ورد عطر على باب قبرها.
وبعد مضيّ سبع سنوات، وقبل حلول موعد الزيارة، أتى كونار إلى حيث ترقد أمّه. لكن هذه المرّة جلس على الأرض. وبكى كثيرًا وهو يقول: «يا أمّي الحبيبة. ها إني جئت اليوم لأودّعك، وأقول لك إني مسافر غدًا إلى مكان بعيد لأعمل فلا أبقى عبئًا على أخوتي. هذه السنة لن أستطيع أن آتي إليك في الموعد كما في كلّ سنة. ولا أعرف إن كنت ستسامحينني وترضين عني». وللحال هبّت نسمة رقيقة داعبت أوراق الشجرة التي تظلّل القبر، وعبثت بشعر رأسه الناعم.