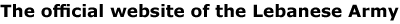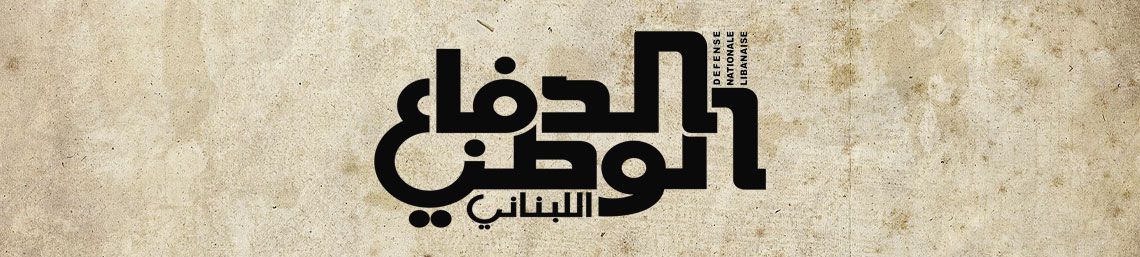العلاقات الأميريكية - الصينية: من التعاون ألى التنافس فالاستقرار الحذر
المقدمة
منذ أن أقامت الولايات المتحدة الأميركية علاقات دبلوماسية مع الصين في العام 1979، استندت سياستها إلى حد كبير على أمل أن تدفع المشاركة بين الجانبَين بالانفتاح الاقتصادي والسياسي الصيني، وأن يؤدي ذلك إلى بروز الصين كأحد الأطراف البنّاءة والمسؤولة في العالم، وأن يصبح مجتمعها أكثر انفتاحًا. لكن، بعد أكثر من 45 عامًا، أصبح واضحًا أن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار تمامًا مدى رغبة الحزب الشيوعي الصيني في تقييد نطاق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وفي اعتماد سياسة تتوافق مع القيم الصينية التي تختلف عن المثل الديموقراطية الغربية. على مدى العقدَين الماضيَين، تباطأت الإصلاحات، بالنسبة إلى الغرب، أو توقّفت أو سارت في الاتجاه المعاكس. لم يحقّق التطور الاقتصادي السريع الذي بلغته بكين وزيادة انخراطها مع العالم التقارب مع النظام الحر كما كانت تأمل الولايات المتحدة الأميركية. اختار القادة الصينيون إعادة تشكيل النظام الدولي بما يتوافق ومصالحهم. دفع هذا الأمر الإدارة الأميركية إلى التصدي لتحدي بكين، واعتماد نهج تنافسي معها، تجلّى بوضوحٍ مع دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في العام 2017.
ستتناول هذه الدراسة في قسمها الأول علاقات التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية، القوة العظمى القائمة، والصين، القوة العظمى الصاعدة. يستعرض القسم الثاني تحول هذه العلاقة إلى التنافس ويبرز أهم محاوره.
القسم الأول
التعاون الأميركي - الصيني في حقبة ما بعد الحرب الباردة
يتناول هذا القسم خلفيات التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحتى العام 2008، ويبيّن رؤية كل من الدولتَين لهذه العلاقة.
أولاًً: خلفيات التعاون
رأى عالم السياسة الأميركي دايفيد أيدلشتاين David Edelstein أنه يمكن تفسير دوافع التعاون والتنافس بين القوى العظمى القائمة والصاعدة من خلال قياس الدرجة التي تقيّم فيها الدول المستقبل بالنسبة إلى الحاضر1. بمعنى آخر، يحفّز عدم اليقين بشأن النوايا المستقبلية على تبنّي القوى العظمى القائمة سياسات تعاونية تجاه القوى العظمى الصاعدة بدلًا من تنفيذ سياسات تنافسية على المدى القصير، على عكس ما تنادي به الأدبيات الواقعية الموجودة. تفضّل القوة العظمى القائمة اتباع علاقات تعاونية وسياسة المشاركة مع القوة العظمى الصاعدة حتى تصبح النية الطويلة المدى لهذه القوة قابلة للقياس وتشكّل خطرًا واضحًا عليها، الأمر الذي سيحفّز لاحقًا القوة العظمى القائمة على تغيير استراتيجيتها من التعاون إلى التنافس2.
تعتبر الأدبيات الواقعية الحالية أن حالة عدم اليقين بشأن النوايا الطويلة المدى ستؤدي حتمًا إلى قيام الدول، الموجودة أصلًا في بيئة دولية تتميّز بالفوضى والاتكال على الذات، والانخراط باستمرارٍ في المنافسة مع بعضها. في هذا الإطار، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد جون ميرشايمر John Mearsheimer أن القوة العظمى القائمة سوف تنخرط باستمرارٍ في استراتيجيات تنافسية تجاه القوة العظمى الصاعدة لمنعها من أن تصبح منافسة لها، وذلك ببساطةٍ لأن عدم اليقين بشأن النوايا يحفّز القوة العظمى القائمة على التصرف بناء على أسوأ السيناريوهات المستقبلية لسلوك القوة العظمى الصاعدة3. لذلك وصف ميرشايمر سياسة المشاركة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي في التعامل مع الصين بـأسوأ خطأ استراتيجي ترتكبه أي دولة في التاريخ الحديث، وأنّه «لا يوجد مثال لقوة عظمى تعمل بنشاطٍ على تعزيز صعود منافس لها»4.
ناقض أيدلشتاين وجهة النظر هذه معتبرًا أن القوى العظمى الحالية لا تفترض مسبقًا الأسوأ في ما يتعلّق بمستقبل القوى العظمى الصاعدة المنافسة عندما تكون غير متأكدة بشأن السلوك المستقبلي. لا تنخرط في التنافس لأن التكاليف التي ستتحملها، استنادًا إلى نوايا غير معروفة، يمكن أن تكون غير جذابة لأسبابٍ سياسية واقتصادية واستراتيجية محلية وخارجية. على الصعيد المحلي، تؤدي الاستراتيجية التنافسية إلى استنزاف الموارد وتذمّر المواطنين. على المستوى الخارجي، يصرف هذا الأمر تركيز القوة العظمى عن التحديات الأخرى الواضحة والوشيكة التي تواجه أمنها5. بالتالي، من الأرجح أن تقوم القوى العظمى القائمة بـتأجيل التنافس والبحث عن فرص لتحديث أي تفكير حول نوايا القوة الصاعدة6.
استنادًا إلى ما سبق، يوجد ثلاثة متغيرات رئيسة تدفع قوة عظمى قائمة إلى إطلاق منافسة استراتيجية وقائية ضد قوة عظمى صاعدة الآن، أو تؤجل مثل هذا الإجراء إلى وقت لاحق:
- إذا كانت القوة العظمى الحالية متأكدة من النوايا الطويلة المدى للقوة العظمى الصاعدة.
- إذا كان من الممكن تحقيق مكاسب اقتصادية قصيرة المدى من خلال الانخراط في علاقات تعاون مع القوة العظمى الصاعدة.
- إذا كانت هناك تحديات أخرى واضحة ووشيكة لأمن القوة العظمى القائمة.
كلما زاد التأكد من أن النوايا الطويلة المدى للقوة العظمى الصاعدة تشكّل تهديدًا، وكلما انخفضت فرص الحصول على فوائد اقتصادية من علاقات التعاون مع القوة العظمى الصاعدة، ومع غياب تحديات واضحة وشيكة أخرى يجب معالجتها، زاد احتمال تبنّي القوة العظمى القائمة سياسات تنافسية على المدى القصير لمواجهة التحدي الواضح على المدى الطويل. في الحالة المعاكسة، تزيد احتمالات قيام القوة العظمى الحالية بتأجيل التنافس إلى وقت لاحق وتبنّي سياسات تعاونية على المدى القصير.
يتعلق سلوك القوة العظمى القائمة بتبنّي استراتيجية تعاونية أو تنافسية قصيرة المدى تجاه قوة عظمى صاعدة بتصرّفات هذه الأخيرة. من الواضح أنه يجب على القوة الصاعدة أن تمتنع، على المدى القصير، عن القيام بأي عمل يدفع القوة القائمة إلى اعتباره تهديدًا طويل المدى إذا أرادت تطوير قدراتها. فهي تحتاج لأن تتعاون اقتصاديًا مع القوة القائمة وغيرها من البلدان المتقدمة والغنية لتأمين صعودها7.
باختصارٍ، تتطور السياسات التعاونية والتنافسية بين القوى العظمى القائمة والصاعدة فتنشأ العلاقات التعاونية، عندما تكون قوة عظمى قائمة غير متأكدة من نوايا القوة العظمى الصاعدة على المدى الطويل، وعندما تكون هناك فوائد قصيرة المدى من التعاون يمكن أن تحصل عليها، في نفس الوقت الذي تتبع فيه القوة العظمى الصاعدة سياسة تهدف إلى تغذية علاقاتها التعاونية على المدى الطويل من خلال التعاون وتأجيل أي إجراء فوري يمكن أن يثير المخاوف بشأن نواياها على المدى الطويل. من ناحية أخرى، يحدث التنافس عندما تركّز القوى العظمى الحالية على التهديد الطويل المدى الذي تشكله قوة عظمى صاعدة وتغيب فوائد التعاون، وهو ما يتسبّب في المقام الأول في السلوك الاستفزازي للأخيرة الذي يثير المخاوف بشأن نواياها الطويلة المدى8.
ثانيًا: رؤية الولايات المتحدة الأميركية
شكّل عدم اليقين بشأن نوايا الصين على المدى الطويل، والفوائد الاقتصادية من التعاون، والتحديات الواضحة لعولمة النظام الليبرالي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، ومعالجة التهديد الإرهابي منذ العام 2001، حافزًا للولايات المتحدة على الانخراط في علاقات تعاون مع الصين، القوة العظمى الصاعدة، وساعدت في تعزيز صعودها.
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، تبنّى صنّاع السياسات الأميركيين سياسة المشاركة Engagement Policy بهدف تعزيز السلام والديموقراطية على الصعيد العالمي من خلال تشجيع انتشار الديموقراطية واقتصادات السوق إلى الأماكن التي لم تترسّخ فيها جذورها بعد، وبخاصةٍ الصين9. ساد الاعتقاد في حينه أن هذه السياسة كانت قادرة على حث نوايا الصين الطويلة المدى وتغييرها، مهما كانت، في اتجاه مناسب10.
كان صانعو السياسة الأميركيون يأملون، في الواقع، في توسيع حدود النظام الغربي، وتوسيع نظام جزئي يعمل على المبادئ الليبرالية ليشمل العالم بأسره، بما في ذلك الدول التي اختارت سابقًا البقاء خارجه. كان المنطق وراء هذا التوسع، هو أن عولمة الديموقراطية الليبرالية وتعزيز المؤسسات الدولية والاقتصاد الدولي المفتوح، من شأنها، تسهيل السلام والاستقرار العالميَين، كما ضمنت ذلك بين الدول الغربية خلال الحرب الباردة11، وتؤدي إلى نهاية التاريخ، على حد قول فوكوياما Fukuyama12. حقّقت الولايات المتحدة الأميركية بعد ذلك تفوّقًا استراتيجيًا وأيديولوجيًا غير مسبوق، حيث أصبح بداية القرن الواحد والعشرين عصر عدم توازن القوى الصارخ لصالحها عن طريق الهيمنة الشاملة على العالم وتكريس سياسة القبضة الحديدية واستخدام التفوق العسكري الكاسح لحماية مصالحها. كما امتلكت الولايات المتحدة الأميركية السيطرة الاقتصادية وأصبحت تعمل على تقييد طموحات الدول الأخرى فأخضعت النظام العالمي لقواعد هي أساسًا متطلبات الاقتصاد الأميركي.
في الوقت نفسه الذي أعربت فيه إدارة كلينتون عن عدم اليقين بشأن نوايا الصين على المدى الطويل، كان لديها اعتقاد راسخ أيضًا بأن المسار المستقبلي للنظام الدولي الليبرالي المتطوّر يعتمد على إدماج الصين فيه. كانت ذروة مشروع الهيمنة الليبرالية دعوة الولايات المتحدة الأميركية الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وافتتحت بعضويتها عصر العولمة الحديثة13.
بالإضافة إلى المساعدة في توسيع النظام الدولي الليبرالي المتطور وتنمية العولمة، أفاد دمج الصين في النظام الدولي الليبرالي الاقتصاد الأميركي أيضًا. ضمنت الولايات المتحدة الأميركية استمرار الوصول إلى السوق المحلية المزدهرة في الصين، وبالتالي تأمين استمرار تصدير منتجاتها، وفرص العمل لمزارعيها وعمّالها وشركاتها14. أصبحت الصين، في الواقع، واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أخيرًا، كان من شأن التكامل أن يؤدي إلى تغيير سلوك الصين في الأمد البعيد، وتحويلها إلى صاحب مصلحة مسؤول في النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية15.
أدى رد الولايات المتحدة الأميركية على هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية أيضًا دورًا مهمًا في دفعها إلى التعاون مع الصين وتجميد الخطط لتبنّي سياسة تنافسية ضدها ردًا على التبدّل الذي طرأ على سلوكها16. أدى انخراط الجيش الأميركي في التزامات طويلة الأجل في أفغانستان والعراق إلى تحويل انتباه واشنطن بعيدًا عن مناطق أخرى، بما في ذلك آسيا. عوضًا عن ذلك، أكدت استراتيجية الأمن الوطني الأميركية للعام 2002 ترحيب الولايات المتحدة الأميركية بظهور الصين القوية والمسالمة والمزدهرة كشريكٍ في الحرب العالمية ضد الإرهاب، وفي الحفاظ على السلام والأمن الدوليَين بشكلٍ عام17. فعرفت العلاقات الصينية-الأميركية أكثر اللحظات استقرارًا في حقبة ما بعد الحرب الباردة18، للأسباب الآتية: أولًا، صرفت الحرب على الإرهاب انتباه الولايات المتحدة الأميركية عن التحدي الطويل الأمد الذي تفرضه الصين، وذلك من خلال استهلاك انتباه واشنطن على المدى القصير لمعالجة التحدي الإرهابي19. كان السبب الثاني هو القرار الصيني بدعم الولايات المتحدة الأميركية ضد الحرب العالمية على الإرهاب وإقامة شراكة معها20. أخيرًا، كان يُعتقد أنه من شأن سياسة المشاركة المستمرة أن تحفّز بكين على تغيير المسار والتعاون العملي بشأن قضايا الأمن الإقليمية والدولية21.
ثالثًا: رؤية الصين
سمح كل ذلك للصين بتوسيع حضورها الاقتصادي الإقليمي والعالمي وتأثيرها، أحيانًا، على حساب الولايات المتحدة الأميركية. على الرغم من أن حملة الولايات المتحدة الأميركية للهيمنة الليبرالية أدت إلى مخاوف في الصين بشأن بقاء نظامها، إلا أنها وفرت فرصة أيضًا لمتابعة الهدف طويل المدى المتمثّل في التجديد الوطني من خلال التكامل والتفاعل الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية والعالم المتقدم. هدفت المشاركة الصينية في النظام القائم إلى إفساح المجال أمامها على التركيز على الإصلاحات الداخلية الطويلة المدى والتنمية، وعلى منع الولايات المتحدة الأميركية من التركيز على احتواء صعود الصين كقوةٍ عظمى عالمية22.
كما أشرنا سابقًا، تأثّر سلوك الولايات المتحدة الأميركية بتبنّي استراتيجية تعاونية قصيرة المدى تجاه الصين بتصرّف هذه الأخيرة. فالصين، القوة العظمى الصاعدة اتّبعت مقولة زعيمها دينغ تشاو بينغ Deng Xiaoping بإخفاء قدراتها وكسب الوقت Bide your time Hide your strength حتى اللحظة المناسبة لإظهارها، واضعة أمامها هدفًا استراتيجيًا بالوصول إلى الازدهار والمكانة العالمية في المستقبل، ومبقية القوى العظمى الحالية غير متأكدة بشأن نواياها الطويلة المدى، فتتعاون معها هذه الأخيرة على المدى القصير لتحقيق مكاسب على المدى البعيد23.
تمكنت الصين بنجاحٍ من اتباع هذا المبدأ، خلال الفترة التي تلت نهاية الحرب الباردة، من خلال الامتناع عن الانخراط في أي سلوك يمكن أن يستفز الولايات المتحدة الأميركية24. من خلال الإشارة إلى النوايا الحميدة، والانفتاح على التواصل الاقتصادي، واتخاذ خطوات للاندماج في النظام الدولي الليبرالي والشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ضد الإرهاب العالمي، تمكنت الصين من إبعاد الولايات المتحدة الأميركية عن تبنّي استراتيجيات تنافسية لاحتواء صعودها. تعد سياسات الإصلاح والانفتاح التي سار وفقها دنغ شياو بينغ، ومبدأ إخفاء القدرات وانتظار الوقت، ومفهوم النهضة السلمية، من أهم تجليات هذا النهج25. كما اعتمدت سياسة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لبناء النوايا الحسنة وتجنّب المواجهة، وركّزت على سياسات الربح للجميع القائمة على التعاون الاقتصادي والتقليل من قدراتها العسكرية المتنامية ونفوذها الاقتصادي على الدول الأصغر لتهدئة المخاوف بشأن قوتها العسكرية الصاعدة26.
ساعد النمو الاقتصادي السريع والمستدام للصين، لا سيما بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، الحزب الشيوعي الصيني على زيادة شرعيته المحلية بالاستناد على قدرته في بناء قوة الصين ورفع مستويات المعيشة. كما أعطى هذا النمو، الذي حافظ على نسبة تقارب 8% وبخاصةٍ خلال الأزمة الآسيوية المالية27، لقادتها المزيد من الموارد وقنوات النفوذ الجديدة حيث أصبحت دول أخرى تعتمد على الوصول إلى السوق الصينية وسعت للحصول على قروض ومساعدات اقتصادية من بكين. سمح ذلك للصين بتوسيع نفوذها الاقتصادي خارج منطقة المحيطَين الهندي والهادئ وزيادة مكانتها العالمية.
إلا أنه كانت هناك فترات خلال التسعينيات تصرّفت فيها الصين بطرقٍ اعتبرتها الولايات المتحدة الأميركية والقوى الإقليمية الأخرى في المنطقة بمثابة مؤشرات على نوايا خبيثة طويلة المدى، لا سيما في ما يتعلّق ببحر الصين الجنوبي وتايوان. زادت المطالبات بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، وبخاصةٍ من قبل فييتنام والفيليبين، بحلول العام 1994، لتعزيز مواقع الدولتَين وغيرها من الدول الإقليمية في المنطقة على حساب الصين حيث كانت الأخيرة حريصة على عدم تأجيج أي تصوّر للتهديد28. كانت بكين تواجه خيارًا من اثنين: إما عدم التصرف والمخاطرة بتآكل موقفها الإقليمي أو العمل للدفاع عما تعده حقها السيادي والمخاطرة بإثارة المخاوف بشأن نواياها الطويلة المدى29. اختارت الصين الخيار الأخير وسيطرت بين عامَي 1994 و1995 على جزر ميستشيف ريف Mischief Reef التي تدّعي الفيليبين ملكيتها، ثم قامت بتحصينها في ما بعد، معلنة ملكيتها، وذلك لمنع المزيد من التآكل في موقعها30.
خلال الفترة نفسها التي انخرطت فيها بكين في إجراءات حازمة في بحر الصين الجنوبي، كانت تخشى بشكلٍ متزايد من تحدّي الولايات المتحدة الأميركية لها بسبب مطالبتها باستعادة تايوان. جاء هذا التحدي الملحوظ في أعقاب مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة، وتحسين العلاقات الدبلوماسية معها انتهاكًا للاتفاقيات القائمة بينها وبين والصين، والقرار الذي اتخذته إدارة كلينتون في العام 1995 بالسماح للرئيس التايواني لي تنغ هوي Lee Teng-hui بزيارة الولايات المتحدة الأميركية. واجهت الصين معضلة الرد الآني أو التأجيل خوفًا من أن تشجّع هذه التطورات تايوان في النهاية على السعي إلى الاستقلال31. كان قرار الصين هو التصرف فورًا وإطلاق تدريبات عسكرية واسعة النطاق واختبارات صاروخية في المياه القريبة من الجزيرة بين عامَي 1995 و1996 لإظهار التصميم وردع أي تحرك نحو الاستقلال. بلغت أزمة مضيق تايوان الثالثة ذروتها بنشر مجموعتَين من حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة في العام 1996، وهي أكبر حركة بحرية أميركية على الإطلاق في المنطقة منذ حرب فييتنام32.
غير أن الصين عادت مجددًا إلى مواجهة التصوّر الناشئ لدى جيرانها والولايات المتحدة الأميركية عن التهديد الصيني، لا سيما من خلال تطوير مفهوم الصعود السلمي اعتبارًا من العام 1996 33. تم التعبير عن مفهوم الصعود السلمي من خلال التزام الصين بتحقيق حل سلمي للصراع في قضايا بحر الصين الجنوبي وتايوان، ودورها النشط في تطوير حل متعدد الأطراف للتحديات الأمنية، الإقليمية والدولية، كقضية السلاح النووي لكوريا الشمالية. كما تجلّى الصعود السلمي من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي مع البلدان المجاورة، وبخاصةٍ مع رابطة دول جنوب شرق آسيا أي آسيان، والانتساب إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001، وأخيرًا من خلال الانضمام إلى الحرب العالمية ضد الإرهاب34. كانت هذه السياسات حاسمة لتأمين بيئة مؤاتية مستمرة للتجديد الوطني من خلال موازنة أي تحرك من جانبها، أو القوى الإقليمية الأخرى، لتطويق بكين خوفًا على نواياها الطويلة المدى35.
لم يصمد هذا التصوّر وقتًا طويلًا. في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، برزت عدة تطورات أدت إلى إزالة الحوافز التي كانت تدفع نحو التعاون على المدى القصير بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. إذ نشأ تصوّر لدى الولايات المتحدة الأميركية أن الصين تسعى للهيمنة الإقليمية في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ بسبب ما اعتبرته واشنطن سلوك الصين الحازم في بحر الصين الجنوبي. بعبارةٍ أخرى، عندما أفسح عدم اليقين المجال للوضوح، سواء أكان ذلك صحيحًا أم لا، بشأن النوايا الطويلة المدى، وعندما برز التنافس الاقتصادي وبداية انفصال البلدَين اقتصاديًا، وتلاشى التهديد الإرهابي بدأت الولايات المتحدة الأميركية تتخلّى عن سياسة المشاركة وأطلقت منافسة استراتيجية وقائية هدفت إلى مواجهة التحدي الصيني الواضح والطويل الأمد. بدأت ملامحها مع إدارة أوباما من خلال التوجه نحو آسيا Pivot to Asia في العام 2011، ثم تسارعت في وقت لاحق مع استراتيجية إدارة ترامب الحرة والمفتوحة في المحيطَين الهندي والهادئ Free and Open Indo-Pacific بدءًا من العام 2017 36.
القسم الثاني
محاور التنافس الصيني الأميركي
يناقش هذا القسم التنافس بين الولايات المتحدة الأميركية والصين في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى التنافس على النفوذ العالمي.
أولاًً: التنافس في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ
نشأ تصوّر لدى الولايات المتحدة الأميركية أن الصين تسعى للهيمنة الإقليمية في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ بسبب ما اعتبرته واشنطن سلوك الصين الحازم في بحر الصين الجنوبي. شمل هذا التنافس بين الدولتَين النفوذ في منطقة شرق آسيا وجزيرة تايوان أيضًا، الأمر الذي فاقم المعضلة الأمنية في المنطقة.
1 . التنافس على السيطرة على بحر الصين الجنوبي
أعربت الصين عن عدم رضاها عن الوضع السائد في منطقة بحر الصين الجنوبي وسعت للسيطرة عليه، ولا نية لديها للتفاوض حول المطالب الإقليمية لجيرانها، ويرجع ذلك إلى المصالح النفطية وضغوط شركات النفط، ورغبة الصين في الصعود كقوةٍ عظمى، وهو ما يعتمد على توافر إمدادات كافية من النفط والغاز37.
يعد بحر الصين الجنوبي إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، حيث يتنافس البلدان على النفوذ والقوة في المنطقة التي يعتبرها كل منهما مهمة من الناحية الجيو-استراتيجية. يُعدّ بحر الصين الجنوبي ممرًا لثلث التجارة البحرية العالمية، ويحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعيَين. طالبت الصين بمساحة 310,000 ميل مربع من البحر كجزءٍ من مياهها الإقليمية، بحيث تمتد إلى حدود كل دولة تقريبًا في المنطقة38. تصل مطالباتها الإقليمية إلى أقصى الجنوب مثل ماليزيا، في منطقة تسمى التسعة - داش لاين، كما يظهر في الخريطة الرقم 1 39.
لم تعترف الصين بالقرار الصادر في العام 2016 عن هيئة التحكيم الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة والذي قضى بأن الصين لا تملك حقوقًا تاريخية على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي، وأيّدت المحكمة موقف الفيليبين في القضية41. أكدت المحكمة أيضًا أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفيليبين في المنطقة، من خلال التدخّل في أعمال الصيد واستخراج النفط وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة42. أشار رفض حكم التحكيم إلى جهد من جانب الصينيين للحصول على استثناء في كيفية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على الأقل في بحر الصين الجنوبي. اختلفت الصين عن الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى في تفسيراتها لبعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبخاصةٍ في ما يتعلق بممارسة الأنشطة العسكرية في المناطق الاقتصادية الخالصة وما إذا كان يتعيّن على السفن العسكرية الأجنبية طلب إذن الدخول إلى المياه الإقليمية لبلدٍ ما.
لم ترفض الصين القرار فقط، بل ذهبت إلى حد توسيع الجزر المتنازع عليها بشكلٍ مصطنع في المنطقة لبناء المنشآت العسكرية عليها. أدت تصرفاتها وإعلان الولايات المتحدة الأميركية ضرورة التزام الصين بالقانون الدولي وحرية الملاحة إلى مواجهات مع البحرية الأميركية ودول أخرى داخل منطقة بحر الصين الجنوبي. كما شكّل التوسع العسكري الصيني في المنطقة مصدر قلق ملحوظ للأميركيين43.
كشفت الصين أيضًا عن نيتها وجهودها للحد من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة خلال مفاوضاتها مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أي آسيان بشأن مدوّنة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي. اقترحت الصين شرطَين في المدوّنة يحظّران التعاون مع شركات الطاقة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع دول خارج المنطقة44. لن يقتصر البند الأول على تقييد حرية دول المنطقة لمتابعة سياسة استخراج الطاقة الخاصة بها، ولكنها ستوفر للصينيين أيضًا، باعتبارهم الطرف الوحيد في مدوّنة النفط التي تتمتع بتكنولوجيا وخبرة الحفر العميق، احتكارًا لأي استغلال للموارد الطبيعية في المنطقة. يحظّر البند الثاني أي تدريبات عسكرية مع قوى أجنبية ما لم توافق جميع الدول الموقّعة على ميثاق المعاهدة، وبالتالي تمنح الصين حق النقض على جميع التدريبات في المنطقة. لم تحظَ هذه الأحكام بدعم دول آسيان الأخرى، لكنها عبّرت بوضوحٍ عن النوايا الصينية.
يعود اهتمام الصين بالمنطقة إلى نظرية ألفريد ماهان Alfred Mahan التي أطلقها في كتابه «تأثير القوة البحرية على التاريخ» والتي لا تزال تجذب العديد من الاستراتيجيين الصينيين. ذكر ماهان أن الاعتماد الأكبر على التجارة البحرية يبرّر امتلاك أسطول حربي، والقوة البحرية تتناسب بشكلٍ مباشر مع المكانة الاستراتيجية للأمة45. كما أعلن أن قوة الدولة البحرية تعتمد بشكلٍ خاص على موقعها الجغرافي وقدرة التحرّك لقواتها البحرية46. بما أن الصين تعد أكبر مصدّر في العالم، كما أن أكثر من ثلث التجارة البحرية العالمية تمر عبر بحر الصين الجنوبي، لا سيما النفط من الشرق الأوسط، الذي تعتمد عليه بشكلٍ كبير، لذلك، من شأن النتائج التي توصّل إليها ماهان أن تساعد في تفسير طموحات الصين البحرية.
إضافة إلى ذلك، يعود سبب مثل هذا التركيز الصيني الاستراتيجي في بحر الصين الجنوبي، وبخاصةٍ ضد نفوذ الولايات المتحدة الأميركية ، هو أن الصين تعتبر الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وسيلة لتقييد نمو الصين كقوةٍ منافسة وللحفاظ على وجودها العسكري وهيمنتها في المنطقة47. فالصين لا تثق بالليبرالية والديموقراطية التي تروّج لها الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، والتي تعدها الصين بمثابة ثقل موازن لنفوذها48. تشكّل هذه القضايا التي تطرحها الولايات المتحدة الأميركية عقبات أمام الطموحات الصينية لتحقيق ما يعادل نسخة حديثة من مبدأ مونرو في جنوب شرق آسيا. تسعى بكين إلى تحقيق هذه الأهداف لإنشاء مجال نفوذ يسمح لها في بسط سيطرتها على التيبت وتايوان وهونغ كونغ، وضمان حصولها على الاحترام الذي تستحقه كقوةٍ عظمى، واستعادة دورها المهيمن في آسيا الذي كانت تتمتع به قبل التغريب.
في المقابل، تعتبر الولايات المتحدة الأميركية بحر الصين الجنوبي مياه دولية وترفض مطالبات الصين فيه، واصفة تصرفات الصين أنها خطيرة ومنافية للقانون الدولي، وبالتالي هي تعمل كقوةٍ تعديلية تريد تغيير المعايير والنظام الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية49. من الناحية الاستراتيجية، يُعد بحر الصين الجنوبي الطريق الجوي والبحري للقوات الأميركية التي تناور بين المحيطَين الهندي والهادئ. لذلك تزعم الولايات المتحدة الأميركية أن القوات الصينية في المنطقة تُقوّض حرية الحركة التي تسهّل التجارة والدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في بحر الصين الجنوبي، إذ تعتمد الاستثمارات الأميركية في جنوب شرق آسيا إلى حد كبير على حرية الحركة في المنطقة50.
2 . التنافس على النفوذ في منطقة شرق آسيا
قامت الولايات المتحدة الأميركية بانتظامٍ بنشر حاملات طائراتها في منطقة شرق آسيا في تدريبات على حرية الحركة، وطائرات تجسس، كوسيلةٍ للحصول على معلومات استخباراتية عن الأنشطة الصينية. كما سعى حلفاؤها إلى التمركز في المنطقة أيضًا، فأرسلت المملكة المتحدة إحدى حاملتَي طائراتها إليها، في حين نشرت البحرية اليابانية ثلاث سفن في بحر الصين الجنوبي51. في أيلول 2020، بدأت الولايات المتحدة الأميركية مشروعًا بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة فييتنام وميانمار وكمبوديا وتايلاند لمكافحة الآثار البيئية للسدود الصينية المتعددة على نهر ميكونغ Mekong، وأعربت فييتنام عن دعمها لدور الولايات المتحدة الأميركية في الوضع في بحر الصين الجنوبي، أما ماليزيا ففضّلت عدم إزعاج الصين بسبب اعتمادها عليها كأكبر وجهة تصدير لها52. على الرغم من أن الفيليبين انحرفت تجاه الصين في السنوات الأخيرة بسبب رغبتها المعلنة في أن تصبح أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنها عادت إلى موقفها التقليدي المؤيّد للولايات المتحدة بعد انقضاء ولاية الرئيس رودريغو دوتيرتي Rodrigo Duterte في أيار من العام 2022 وتسلّم خلفه فرديناند ماركوس جونيور Ferdinand Marcos Jr الحكم53.
في المقابل، ترد وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الولايات المتحدة الأميركية تروّج لفكرة الاستفزاز الصيني في المنطقة كوسيلةٍ لتبرير ادعاءاتها بالهيمنة. حوّلت الصين مؤخرًا سياستها الخارجية من رد فعل هادئ ودفاعي سببه «قرن الإذلال»، وهي الفترة من العام 1849 إلى العام 1949 التي شهدت القهر والسيطرة، إلى دبلوماسية المحارب التي تصر على احترامها كقوةٍ عالمية مستعدة لمواجهة خصومها. أظهرت الصين باستمرارٍ استعدادها التخلّي عن المؤسسات القائمة عندما لا تكون ضمن مصلحتها. كما أنشأت مبادرة الحزام والطريق لتصدير ما قيمته 150 مليار دولار من قدرة البنية التحتية لطريق الحرير الحديث في جميع أنحاء آسيا وبعض أوروبا، وتحويل الاقتصاد العالمي الحالي لجعل هذه المناطق أكثر اعتمادًا على الاستثمار الصيني، وأنشأت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنافسة البنك الدولي، مع قروض تنافسية لتوسيع نفوذها الاقتصادي وموازنة القوة المصرفية الغربية54.
إضافة إلى ذلك، دخلت الصين والولايات المتحدة الأميركية في أنشطة تنافسية حول تايوان، التي تنظر إليها الصين كجزء من إقليمها. في العقود القليلة الماضية، واصلت الولايات المتحدة الأميركية بيع أسلحة متقدمة إلى تايوان، الأمر الذي اعتبرته الصين تشجيعًا لاستقلال تايوان وتهديدًا لمصالحها55. احتجت الصين مرارًا وتكرارًا على مسألة مبيعات الأسلحة إلى تايوان ولكن من دون جدوى. ترى الصين في هذه التحركات محاولة لتغيير توزيع القوة في المنطقة. في المقابل، هددت الصين تايوان ضد التحركات المطالبة بالاستقلال ونشرت صواريخ في البر الرئيس أيضًا. أدى ذلك إلى تشكيك الولايات المتحدة الأميركية في نوايا الصين في تعاملها مع تايوان، ما من شأنه أن يوقع القوتَين في معضلة أمنية، كما يمكن لحالة التنافس أن تؤدي إلى صراع بين الطرفَين وبخاصةٍ أن احتمال حدوث حسابات خاطئة من جانب الصين أو تايوان أو الولايات المتحدة الأميركية كبير جدًا.
كما تؤدي واشنطن أيضًا ورقة اليابان، الهند، كوريا الجنوبية وأستراليا لاحتواء التمدد الصيني الآخذ بالاتساع في بحر الصين وجنوب المحيط الهادئ، حيث تدور خلافات على ملكية العديد من الجزر الصغيرة التي تريدها بكين موطئ قدم لتمددها البحري في ما تعتبره منطقة نفوذها، والخروج منه إلى أعالي البحار والمناطق الأبعد مسافة.
نتج عن هذا التنافس في منطقة شرق آسيا تعزيز المعضلة الأمنية بين بكين وواشنطن من جهة، وسباق تسلّح بين الصين والدول المجاورة لها من جهة أخرى. الجدير ذكره أن المعضلة الأمنية تنشأ بسبب الخطوات التي تتخذها دولة ما لزيادة أمنها وتعزيزه ما يجعل الآخرين أقل أمانًا. فعندما تشعر دولة ما بأنها غير آمنة وتسعى إلى خلق تحالفات أو زيادة تسلّحها، يؤدي ذلك إلى انزعاج الدولة الأخرى وتحسّسها من هذه الخطوة التي تعدها تهديدًا لها، ما يجعلها تتصرّف بنفس النهج، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الشكوك، وينتهي الأمر بافتقاد الأمن بالنسبة إلى الدولتَين. من هذا المنطلق يمكن تقديم تفسير منطقي لرغبة الدول الآسيوية في التسلّح والانضمام إلى الأحلاف، نظرًا لمخاوفها الطويلة المدى بشأن الصين، كما يُفهم سبب اعتبار القادة الصينيين لهذا التطور بالأمر المقلق. تسعى واشنطن إلى الحفاظ على توازن القوى في آسيا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها أن تحافظ على قوتها النسبية وبقائها قوة أحادية مهيمنة. يمكن الحديث عن 6 مظاهر للمعضلة الأمنية في الإقليم:
1 . زيادة الإنفاق العسكري حيث زادت الصين الإنفاق العسكري بنسبة 7.1% في العام 2023، ليصل إلى 209 مليارات دولار، في زيادة هي الأكبر منذ العام 2017. يعكس ذلك عزم الصين على تعزيز قوتها العسكرية وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية. في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأميركي من 716 مليار دولار أميركي خلال العام 2019 إلى 761.6 مليار دولار للعام 2023 56.
2 . عقد صفقات السلاح، حيث قامت الولايات المتحدة الأميركية خلال العقد الماضي بتوقيع صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع الدول المجاورة للصين، مع كل من أستراليا، فييتنام، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية وأندونيسيا.
3 . دعم المناطق التي ترغب بالانفصال عن الصين وهي تايوان، التيبت، هونكونغ والإيغور.
4 . إجراء مناورات عسكرية مع حلفائها في الإقليم وهي تايوان، أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان.
5 . إنشاء تحالفات عسكرية، مثل حلف أوكوس AUKUS مع كل من بريطانيا وأستراليا، حيث سمحت واشنطن لكانبيرا لأول مرة في تاريخها ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا العسكرية المتطورة الأميركية، الأمر الذي وصفته الصين بأنه تصرّف غير مسؤول، والتمسك بعقلية الحرب الباردة57.
٦ . تطويق الصين بحرًا حيث وقّعت الولايات المتحدة الأميركية اتفاقية مع الفيليبين تضمن لها الوصول إلى 4 قواعد عسكرية، ما يوفّر لها قواعد أمامية متقدمة لمراقبة الصين في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان، ووضع معدات عسكرية وبناء منشآت في 9 مواقع في جميع أنحاء البلاد. أُضيفت تلك القواعد في الفيليبين إلى سلسلة القواعد العسكرية الأميركية في شرق آسيا، بما في ذلك القواعد الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية وغوام وأستراليا، ما يجعل القواعد الأميركية نقطة متقدمة مناسبة في حال اندلاع النزاع مع الصين حول تايوان. استكملت واشنطن بهذا الاتفاق الجديد مع الفيليبين، قوس التحالفات العسكرية حول الصين، الممتدة من كوريا الجنوبية واليابان في الشمال إلى أستراليا في الجنوب. وكانت الفيليبين هي الحلقة الأخيرة المفقودة في ذلك القوس، وهي تحد اثنتَين من أكبر بؤر الصراع المحتملة مع الصين، هما تايوان وبحر الصين الجنوبي. هكذا، يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بتعزيز وجودها العسكري في الفيليبين وعبر شرق آسيا وتطويق الصين بالقواعد والقوات (الخريطة الرقم 2 )، تمامًا كما فعل حلف الناتو مع روسيا في وقت سابق، وأدى إلى اشتعال الحرب في أوكرانيا.
ثانيًا: التنافس على النفوذ العالمي
عكس التوسع الصيني في آسيا وأفريقيا وأوروبا استراتيجية الصين لزيادة نفوذها وتوسيع نطاق تأثيرها في العالم. كما أظهر تأسيس بنوك ومؤسسات دولية جديدة من قبل الصين، مثل البنك الآسيوي للاستثمار والبنك الآسيوي للتنمية الذي يهدف إلى منافسة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، الازدياد في الدور الصيني على الساحة الدولية. نظرًا إلى أهمية جنوب شرق آسيا الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية- القوة العالمية- تحتاج الصين إلى مستوى هائل من النفوذ والقوة عالميًا لمنافسة الوجود الأميركي في المنطقة. انتقلت الصين، بالنسبة إلى واشنطن، من سياسة خارجية حذرة وذات بُعد إقليمي إلى سياسة متعددة الارتكازات وذات أبعاد شاملة. تسعى الصين بقدراتها المالية غير المحدودة وقدراتها الديموغرافية والتكنولوجية كي تكون بديلًا عن النموذج الغربي، وتعتمد على البنوك الحكومية كذراعٍ مالية ضاربة، وعلى شركاتها الكبرى أمثال هواوي، وعلى قدراتها الاستثمارية الضخمة لاختراق الأسواق.
نظرت واشنطن بكثيرٍ من القلق إلى توسّع الصين، واعتبرت أن مشاريعها الطموحة مثل طريق الحرير الهادفة لربط الاقتصاد الصيني بقاراتٍ ثلاث، وتسريع إيصال بضائع المصنع الأول في العالم برًا وبحرًا وجوًا، تشكّل خطرًا بالنسبة إلى الحضور الأميركي الذي لا ينحصر بالتجارة والاقتصاد. حاولت الولايات المتحدة الأميركية منافسة مبادرة الحزام والطريق من خلال التعاون مع ست عشرة دولة أخرى، فوقّعت خطة مع تايوان في أيلول 2020 لتقديم برامج تمويل البنية التحتية أكثر شفافية وموثوقية في جميع أنحاء آسيا وأميركا اللاتينية، على الرغم من أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع أقل بشكلٍ ملحوظ من قيمة المشروع الصيني60. كما أطلقت مشروعًا في أيلول 2023، خلال قمة مجموعة العشرين التي تغيَّب عنها الزعيم الصيني في نيودلهي، لإنشاء طريق تجاري يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط من خلال ممرات برية وبحرية شرقية وشمالية (الخريطة الرقم 3 )، لإيقاف التمدد الصيني العالمي على كل المستويات، بتفعيل التناقضات بين نيودلهي وبكين، وبخاصةٍ أن الهند رفضت الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق بسبب نزاعات حدودية مع الصين61.
لم تقف واشنطن عند هذا الحد، فبدأت حربًا تجارية مع الصين في منتصف العام 2018، وأصبحت خلال أول 18 شهرًا لها أخطر اضطراب في التجارة العالمية منذ تسعة عقود63. إذ كشف تقرير أن هذه الحرب، خلال الفترة الممتدة لغاية أيلول 2019، لها نتائج سيف ذو حدّين. خسرت عائدات الصادرات الصينية ثلاثة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة الأميركية (53 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار)، لكن الحرب لم تحقق أي تغيير جوهري في السلوك الاقتصادي الصيني. علاوة على ذلك، خسرت القطاعات الأساسية في الاقتصاد الأميركي، كمصدّري المعادن والخامات، منتجات الغابات، الأعمال التجارية الزراعية وأنظمة النقل، كميات كبيرة من الإيرادات، وانزعجت لأن الصين وجدت مورّدَين عالميَين بديلَين، ما يعني ضررًا دائمًا محتملًا لعائدات صادراتهم64.
لم ينزع انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، حيث إن ترحيب خليفته جو بايدن خلال مؤتمر ميونخ للأمن بالتنافس مع الصين بشرط الشفافية واحترام الملكية الفكرية، أعاد التساؤل في ما إذا كان البلدان يشهدان تنافسًا أم صراعًا بين قوة تستعد للوصول إلى قمة العالم، وأخرى تُصر على البقاء في المقدمة65. لكن لم يُخفِ الرئيس بايدن توجّسه من الصعود الصيني، حيث صرّح لاحقًا بأن الصين تأكل غذاء الولايات المتحدة الأميركية، وهذا أكبر تأكيد على ما تمثّله الصين من خطر عليها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. دفع ذلك بالإدارة الأميركية إلى إعداد خطة لمواجهة الصين، وحرمانها من تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة في السنوات العشر المقبلة، من خلال منع الشركات الصينية من التغلغل في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والضغط على حلفاء واشنطن خارج أوروبا لتقليل شراكاتهم الاقتصادية مع الصين، بالإضافة إلى زيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي، وبين الصين وجيرانها الآسيويين، خصوصًا اليابان والهند، بما يساهم في تراجع النمو السنوي الصيني كي لا يتخطى نظيره الأميركي.
تصاعدت حدّة التوتر بين العملاقَين خصوصًا حول صناعة الرقائق الإلكترونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ قامت واشنطن بمنع شركاتها من بيع الصين أنواعًا محددة من الرقائق، لحرمان بكين من التحوّل إلى قوة تكنولوجية عظمى، وبخاصةٍ في ما يتعلّق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فردّت الصين بتقييد صادرات بعض المعادن المستخدمة في صناعة الرقائق والإلكترونيات إلى الولايات المتحدة الأميركية. تُعد قضية الرقائق قضية أمنية قومية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث تحاول إبقاء قدراتها التنافسية في أعلى مستوياتها، بينما تحاول بكين الاكتفاء الذاتي من الدوائر الإلكترونية المتكاملة، التي تُستخدم في مختلف الصناعات التكنولوجية من الهواتف الذكية إلى أجهزة الحاسوب والسيارات وحتى الصواريخ والأسلحة النووية والأقمار الصناعية. لا يمكن للصين مواجهة منافستها الأولى حتى لو تفوّقت عليها في حجم الاقتصاد ما لم تحسم معركة الرقائق الإلكترونية لصالحها. يمكن أن يكون المسيطر على تصنيع الرقائق حاليًا بمثابة المتحكّم في إمدادات النفط في القرن الـماضي. حاليًا، تمثّل تايوان نحو 92% من الإنتاج العالمي لصناعة أشباه الموصلات بدقةٍ أقل من 10 نانو مترات، ما يجعلها المزوّد الرئيس للغالبية العظمى من الرقائق التي تعمل عليها أكثر الأجهزة تقدّمًا في العالم، وتعد شركة «تي إس إم سي» التايوانية الأولى في العالم بهذا المجال. لذلك تعد تايوان حيوية جدًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية كما هي للصين66.
انخرطت الصين في تنافس سياسي ودبلوماسي مع الولايات المتحدة الأميركية من خلال إنشاء المؤسسات الموازية وتطويرها. تم توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، التي انبثقت عن مجموعة شنغهاي الخماسية التي تضم الصين، كازاخستان، قرغيزستان، روسيا وطاجيكستان، لتشمل دولًا مثل إيران. مع ذلك، ركّزت المنظمة، حتى الآن، على معالجة قضايا واهتمامات أعضائها، مثل جهود مكافحة التطرف والتنمية الاقتصادية، ومن غير المرجح أن تتمتع المنظمة بإمكاناتٍ كبيرة لتحدي البنية الأمنية القائمة في المنطقة أو إزاحتها.
في المقابل، تستعد الولايات المتحدة الأميركية في إطار كبح صعود الصين، لتشكيل تحالف ضدها يضم الدول التي لها خلافات معها، وتشترك في القيم الأميركية ضد الصين ضمن تحالف القيم الذي يضم بالإضافة لحلف الناتو، كوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
شملت سياسة الصعود الصيني أيضًا نشر وزارة الخارجية الصينية ثلاث وثائق رسمية، تناولت الأولى تاريخ الهيمنة الأميركية ومخاطرها67، والثانية مبادرة الأمن العالمي68، والثالثة موقف الصين من الأزمة الأوكرانية69. عكست هذه الوثائق رغبة الصين في تأدية دور أكثر أهمية في النظام الدولي، وصياغة قواعد جديدة له. إضافة إلى ذلك، استضافت الصين توقيع الاتفاق السعودي الإيراني، في إطار جهودها لتعزيز دورها في الشرق الأوسط، وتأدية دور فاعل في حل الأزمات الإقليمية. كما جرى إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، عاكسًا هذا الاختيار تأكيد الحزب الشيوعي الصيني على دوره القيادي، واستمراره في قيادة الصين في السنوات القادمة.
ركّزت وثيقة الهيمنة الأميركية ومخاطرها على انتقاد تاريخها وتداعياتها على السلام والأمن الدوليَين، وسعت الصين من خلال هذه الوثيقة إلى إظهار نفسها كقوةٍ عالمية مسؤولة، تسعى إلى بناء نظام دولي أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا الأمر في سياق نظرة أميركية متزايدة التوتر والحذر إزاء الصين، بدأت مع إدارة أوباما وتصاعدت مع ترامب لتوصف مع الرئيس بايدن بأنها التهديد الأكبر الذي يجب مواجهته ومحاسبته70.
الخلاصة
وضعت الولايات المتحدة الأميركية والصين استراتيجيات، واستخدمتا مقدراتهما الضخمة للتنافس في ما بينهما، بعد حقبة تعاون تراجعت مع حلول العام 2008، لتندثر كليًا في العام 2017، التاريخ الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميًا بداية حقبة جديدة من التنافس الأميركي - الصيني.
أدت المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى مخاوف بشأن احتمال الصدام بين القوتَين. يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التوترات العسكرية المتزايدة، والمنافسة الاقتصادية، والاختلافات الأيديولوجية. تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز وجودها العسكري في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ وتشكيل تحالفات مع شركاء إقليميين، بينما تعمل الصين على توسيع نطاق وجودها العسكري وتتابع مشاريع بنية تحتية طموحة مثل مبادرة الحزام والطريق. كما يشكّل التنافس التكنولوجي أحد الجوانب الأساسية للتفاعل بين البلدَين على مدى عدة عقود، وربما لما بعد العام 2050. يظهر العصر الحالي التحول المتزايد نحو بيئة تكون فيها القيادة التكنولوجية هي المحكّ الرئيس للنفوذ السياسي والقوة الاقتصادية، فضلًا عن كونها أحد المحددات الحاسمة للقوة العسكرية.
غير أن بعض مؤشرات عودة التعاون بين البلدَين عادت إلى الظهور بعد اجتماع القمة الذي انعقد مؤخرًا بين الرئيسَين جو بايدن وشي جين بينج، في تشرين الثاني 2023 بالقرب من سان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية قبل أسبوع من اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادىء، حيث أعاد اللقاء تصويب الأمور بين العملاقَين ودفع إلى التهدئة. أعلن الجانبان عن مجموعة من الإنجازات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والأمنية وحاولا إظهار نفسَيهما بأنهما قادران على إدارة خلافاتهما بشكلٍ فعال، ونتيجة لذلك تراجعت احتمالات النتائج الأكثر كارثية. علاوة على ذلك وعلى الرغم من تضاؤل فرص التوصل إلى ذوبان الجليد الحقيقي الذي يحل الخلافات الجوهرية ويؤدي إلى قدر أعظم من التعاون، فهناك مصادر للاستقرار الحذر تمنع العلاقات من المزيد من التدهور في السنوات المقبلة. سيتطلب الأمر دبلوماسية نشطة لمنع حدوث ذلك في المستقبل ولعل زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة في نيسان 2024 إلى الصين كانت من أبرز تجلياتها.
قائمة المراجع
المواقع الإلكترونية بالعربية
1. CNN العربية، جو بايدن في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: «أنا عند كلمتي.. أميركا عادت»، 19/2/2023، متوافر على الموقع CNN Arabic، الدخول 1/5/2024.
2. Euronews، قمة مجموعة العشرين تختتم أعمالها في نيودلهي وتباين مواقف القادة بشأن نتائجها، مرجع سبق ذكره.
3. الإمارات 71، أردوغان: لن يكون هناك ممر «بين الهند وأروبا» من دون تركيا، 11/9/2023، متوافر على الموقع (uae71.com)، الدخول 1/2/2024.
4. سكاي نيوز عربية، «لا حقوق تاريخية» لبكين في بحر الصين الجنوبي، 12/7/2016، متوافر على الموقع https://rb.gy/hg5kcm، الدخول 29/11/2023.
5. مجيد دياري صالح ، بحر الصين الجنوبي: تحليل جيوبوليتيكي، مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2018.
6. المنشاوي محمد ، الجزيرة، الانتشار العسكري الأميركي عبر العالم، أين وكيف ولماذا وبأي كلفة؟، 16/4/2021، متوافر على الموقع الجزيرة نت، (aljazeera.net)، الدخول 12/11/2023.
الكتب بالأجنبية
1. Doshi Rush, The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order, Oxford University Press, New York, 2021.
2. Edelstein David, Over the Horizon: Time, Uncertainty, and the Rise of Great Powers, Cornell University Press, Ithaca and London, 2017.
3. Fukuyama Francis, The End of History and Last Man, The Free Press, New York, 1992.
4. Goldstein Avery, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International Security, Stanford University Press, Stanford, California, 2005.
5. Hayton Bill, The South China Sea The Struggle for Power in Asia, Yale University Press, New Haven, 2014.
6. Ikenberry John, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crisis of Global Order, Yale University Press, New Haven, 2020.
7. Mahan Alfred, The Influence of Seapower Upon History, 1660-1783, Cambridge University Press, New york, 2010.
8. Mansbach Richard W., Kirsten L. Taylor, Contemporary American Foreign Policy: Influences, Challenges, and Opportunities, SAGE Reference/CQ Press, Los Angeles, 2017.
المجلات بالأجنبية
1. Fravel Taylor M., “China’s Strategy in the South China Sea”, Contemporary Southeast Asia 33, Issue3, January 2011.
2. Goldstein Avery, “China’s Grand Strategy under Xi Jinping: Reassurance, Reform, and Resistance”, International Security 45, Issue 1, Summer 2020.
3. Jefferies William, “China’s Accession to the WTO and the Collapse That Never Was”, Sage Journals, Volume 53, Issue 2.
4. Mearsheimer John J., “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, International Security 43, Issue 4, Spring 2019.
5. Mearsheimer John J., “The Inevitable Rivalry”, Foreign Affairs, Volume 100, Issue 6, November/December 2021.
6. Qimao Chen, “The Taiwan Strait Crisis: Its Crux and Solutions”, Asian Survey, Volume 36, Issue 11, November 1996.
7. Ross Robert S., “The 1995-96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and the Use of Force”, International Security 25, Issue 2, Fall 2000.
8. Shambaugh David, “Sino-American Relations since September 11: Can the New
Stability Last?”, Current History 101, Issue 656, September 2002.
9. Twining Daniel, “America’s Grand Design in Asia”, The Washington Quarterly, Volume 30, Issue 3, 2007.
المواقع الإلكترونية بالأجنبية
1. Abdollapour Behzad, China’s ‘win-win’ development strategy will prevail, Asia Times, 2/10/ 2019, available at https://asiatimes.com/2019/10/chinas-development -policies-in-70-years-perspective/, accessed 27/11/2023.
2. Cole Bernard D., Conflict in the South China Sea, Great Decisions, 2017, available at https://www.jstor.org/stable/pdf/44215462.pdf?refreqid=excelsior%3Aae06231f3b1 e6f7b14c2fc0d49b7b825 accessed 29/11/2023.
3. Dark Manon, South China Sea: Beijing and US Face off at Asian Summit as Pompeo Lashes out at Bullie, Expressco,UK, 10/9/ 2020, available at https://www.express.co.uk/news/world/1333644/south-china- sea-news-us-world-war-3- summit-latest-military-mike-pompeo-latest, accessed 16/10/2023.
4. Donnelly Dylan, South China Sea Dispute Spreads to Mekong River amid Fears US Will Dominate Territory, Express.co.uk, 18/9/ 2020, available at https://www.express.co.uk/news/world/1336051/south-china- sea-us-world-war-3- Mekong-river-xi-jinping-Donald-trump-news, accessed 16/10/2023.
5. Friedman Thomas L., What Comes After the War on Terrorism? War on China? The New York Times, 7/9/2021, available at https://www.nytimes.com/2021/09/07/opinion/ china-us-xi-biden.html, accessed 23/12/2023.
6. Global Firepower, 2023 United States Military Strength, 12/4/2023, available at https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=u nited-states-of-america, accessed 29/11/2023.
7. Kahn Lauren , AUKUS Explained: How Will the Trilateral Pact Shape Indo-Pacific Security?, Council on Foreign Relations, 12/6/2023, available at https://www.cfr.org/ in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security, accessed 19/12/2023.
8. Kuehner Trudy, China’s Encounter with the West: A History Institute for Teachers, Foreign Policy Research Institute, 11/8/ 2016, available at https://www.fpri.org/ article/2008/04/chinas-encounter-with-the-west-a-history-institute-for-teachers/, accessed 16/10/2023.
9. Lake Anthony, From Containment to Enlargement, Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, September 21, 1993, available at https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html, accessed 4/1/2024.
10. Liesman Steve, Trade War Losses for the U.S. and China Grow into the Tens of Billions of Dollars, CNBC, 5/11/ 2019, available at www.cnbc.com/2019/11/05/tradelosses- for-the-us-china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm, accessed 19/12/2023.
11. Lin Miaojung, Chris Horton, A New Belt and Road? US, Taiwan Hook up to Counter China’s Effort, Al Jazeera, 27/11/ 2020, available at https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/27/a-new-belt-and-road-us-taiwan-h ook-up-to-counter-chinas-effort, accessed 16/10/2023.
12. McGleenon Brian, South China Sea: US Praises UK as Allies Prepare to Take Action against Beijing, Express.co.uk, 22/9/ 2020, available at https://www.express.co.uk/news/world/1338733/south-china- sea-us-uk-royal-navy -hms-queen-elizabeth-world-war-3, accessed 16/10/2023.
13. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis, 21/2/2023, available at https://www.fmprc.gov.cn/ mfa_eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html, accessed 28/11/2023.
14. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, The Global Security Initiative Concept Paper, 21/2/2023, available at https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ wjbxw/202302/t20230221_11028348.html, accessed 28/11/2023.
15.Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, US Hegemony and Its Perils, February 2023, available at https://www.mfa.gov.cn/eng/wjbxw/202302/t20230220_ 11027664.html, accessed 28/11/2023.
16. Percival Bronson, U.S. Perspectives on the South China Sea, S. Rajaratnam School of International Studies, 2014, available at https://www.jstor.org/stable/pdf/ resrep05903.9.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187_SYC5188%252Fcontrol& refreqid=excelsior%3Aa4a19fd944ad056bedce9d25e345cece, accessed 16/10/2023, pp. 48-49.
17. Sky News, 14/3/2023, Aukus nuclear submarine deal will help ‘keep oceans free’, says Rishi Sunak, available at https://news.sky.com/story/aukus-nuclear-submarinedeal- will-help-keep-oceans-free-says-rishi-sunak-12833271, accessed 19/12/2023.
18. Thayer Carl, A Closer Look at the ASEAN-China Single Draft South China Sea Code of Conduct, The Diplomat, 3/8/2018, available at https://thediplomat.com/ 2018/08/a-closer-look-at-the asean-china-single-draft-south-china-sea-code-of-conduct/, accessed 2/1/2024.
19. The White House, National Security Strategy 2010, May 2010, available at https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_securit y_strategy.pdf, accessed 28/11/2023, p.37.
20. The White House, The National Security Strategy of the United States of America, United States of America, September 2002, available at https://georgewbushwhitehouse. archives.gov/nsc/nss/2002/, accessed 23/12/2023.
21. Walt Stephen M., How 9/11 Will be Remembered a Century Later, Foreign Policy, 6/9/2021, available at https://foreignpolicy.com/2021/09/06/how-9-11-willberemembered- a-century-later/, accessed 23/12/2023.
22.Wegmann Phillic, Before Trump, US Sold Taiwan More than US $30 Billion in Weapons, Washington Examiner, 5/11/2016, available at https://www.washingtonexaminer.com/ before-trump-us-sold-taiwan-more-than-30-billion-in-weapons, accessed 3/1/2024.
23. Yan Xuetong, From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement, The Chinese Journal of International Politics 7, Issue 2, 2014, available at https://doi.org/10.1093/ cjip/pou027, accessed 23/12/2023.
24. ZhiminChen, China, the European Union and the Fragile World Order, Journal of Common Market Studies 54, Issue 4, 2016, available at https://doi.org/10.1111/ jcms.12383, accessed 23/12/2023.
25. Zhou Jianren, Power Transition and Paradigm Shift in Diplomacy: Why China and the US March towards Strategic Competition? The Chinese Journal of International Politics 12, Issue 1, Spring 2019, available at https://doi.org/10.1093/cjip/poy019, accessed 23/12/2023.
26. Zhuoran Li, The Future of the China-US Chip War, The diplomat, 2/3/2023, available at https://thediplomat.com/2023/03/the-future-of-the-china-us-chip-war/, accessed 14/1/2024.
الهوامش
1 David Edelstein, Over the Horizon: Time, Uncertainty, and the Rise of Great Powers, Cornell University Press, Ithaca and London 2017, pp.5-7.
2 Ibid.
3 John J. Mearsheimer, “The Inevitable Rivalry”, Foreign Affairs, Volume 100, Issue 6, November/December 2021, p. 50.
4 Ibid.
5 Edelstein, op.cit., p.157.
6 Ibid.
7 Edelstein, op.cit., p.158.
8 Edelstein, op.cit.,p.6.
9 Anthony Lake, From Containment to Enlargement, Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, September 21, 1993, available at https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html, accessed 4/1/2024.
10 John Ikenberry, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crisis of Global Order, Yale University Press, New Haven, 2020, p. 263.
11 John J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, International Security 43, Issue 4, Spring 2019, p.8.
12 Francis Fukuyama, The End of History and Last Man, The Free Press, New York, 1992.
13 Ikenberry, A World Safe, op.cit., p.263.
14 The White House, The National Security Strategy of the United States of America, United States of America, September 2002, available at https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/, accessed 23/12/2023.
15 Mearsheimer, The Inevitable Rivalry, op.cit., p.48.
16 Edelstein, op.cit., p.159.
17 The White House, The National Security Strategy 2002, op.cit., p. 27.
18 David Shambaugh, “Sino-American Relations since September 11: Can the New Stability Last?”, Current History 101, Issue 656, September 2002, p.243.
19 Stephen M. Walt, How 9/11 Will be Remembered a Century Later, Foreign Policy, 6/9/2021, available at https://foreignpolicy.com/2021/09/06/how-9-11-will-beremembered-a-century-later/, accessed 23/12/2023.
20 Shambaugh, Sino-American, op.cit., p. 243.
21 Ikenberry, A World Safe, op.cit., p.264.
22 Xuetong Yan, From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement, The Chinese Journal of International Politics 7, Issue 2, 2014, available at https://doi.org/10.1093/cjip/pou027, accessed 23/12/2023, p. 155.
23 Edelstein, op.cit., p.24.
24 Avery Goldstein, “China’s Grand Strategy under Xi Jinping: Reassurance, Reform, and Resistance”, International Security 45, Issue 1, Summer 2020, p. 172.
25 Rush Doshi, The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order, Oxford University Press, New York, 2021, p.125.
26 Behzad Abdollapour, China’s ‘win-win’ development strategy will prevail, Asia Times, 2/10/ 2019, available at https://asiatimes.com/2019/10/chinas-development-policies-in-70-years-perspective/, accessed 27/11/2023.
27 William Jefferies, “China’s Accession to the WTO and the Collapse That Never Was”, Sage Journals, Volume 53, Issue 2, pp. 300-319.
28 Goldstein, op.cit., p.173.
29 Edelstein, op.cit., p. 167.
30 Goldstein, op.cit., p.173.
31 Robert S. Ross, “The 1995-96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and the Use of Force”, International Security 25, Issue 2, Fall 2000, pp. 107-108.
32 Chen Qimao, “The Taiwan Strait Crisis: Its Crux and Solutions”, Asian Survey, Volume 36, Issue 11, November 1996, p.1055.
33 Goldstein, op.cit., p.175.
34 Taylor M. Fravel, “China’s Strategy in the South China Sea”, Contemporary Southeast Asia 33, Issue3, January 2011, pp. 299-300.
35 Doshi, The Long Game, op.cit., pp.104-107.
36 Zhou Jianren, Power Transition and Paradigm Shift in Diplomacy: Why China and the US March towards Strategic Competition? The Chinese Journal of International Politics 12, Issue 1, Spring 2019, available at https://doi.org/10.1093/cjip/poy019, accessed 23/12/2023, p. 20.
37 Bill Hayton, The South China Sea The Struggle for Power in Asia, Yale University Press, New Haven, 2014.
38 Richard W. Mansbach, Kirsten L. Taylor, Contemporary American Foreign Policy: Influences, Challenges, and Opportunities, SAGE Reference/CQ Press, Los Angeles, 2017, p. 377.
39 Bernard D. Cole, Conflict in the South China Sea, Great Decisions, 2017, available at
https://www.jstor.org/stable/pdf/44215462.pdf?refreqid=excelsior%3Aae06231f3b1e6f7b14c2fc0d49b7b825, accessed 29/11/2023, p. 43.
40 دياري صالح مجيد، بحر الصين الجنوبي: تحليل جيوبوليتيكي، مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2018، ص37.
41 سكاي نيوز عربية، "لا حقوق تاريخية" لبكين في بحر الصين الجنوبي، 12/7/2016، متوافر على الموقع https://rb.gy/hg5kcm، الدخول 29/11/2023.
42 المرجع نفسه.
43 Manon Dark, South China Sea: Beijing and US Face off at Asian Summit as Pompeo Lashes out at Bullie, Expressco, UK, 10/9/ 2020, available at
https://www.express.co.uk/news/world/1333644/south-china-sea-news-us-world-war-3-summit-latest-military-mike-pompeo-latest, accessed 16/10/2023.
44 Carl Thayer, A Closer Look at the ASEAN-China Single Draft South China Sea Code of Conduct, The Diplomat, 3/8/2018, available at https://thediplomat.com/2018/08/a-closer-look-at-the asean-china-single-draft-south-china-sea-code-of-conduct/, accessed 2/1/2024.
45 Alfred Mahan, The Influence of Seapower Upon History, 1660-1783, Cambridge University Press, New york, 2010, p.15.
46 Op.cit., p.16.
47 Dylan Donnelly, South China Sea Dispute Spreads to Mekong River amid Fears US Will Dominate Territory, Express.co.uk, 18/9/ 2020, available at https://www.express.co.uk/news/world/1336051/south-china- sea-us-world-war-3-Mekong-river-xi-jinping-Donald-trump-news, accessed 16/10/2023.
48 Trudy Kuehner, China's Encounter with the West: A History Institute for Teachers, Foreign Policy Research Institute, 11/8/ 2016, available at https://www.fpri.org/article/2008/04/chinas-encounter-with-the-west-a-history-institute-for-teachers/, accessed 16/10/2023.
49 McLaughlin, U.S. Strategy in the South China Sea, p. 2.
50 Bronson Percival, U.S. Perspectives on the South China Sea, S. Rajaratnam School of International Studies, 2014, available at https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep05903.9.pdf ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187_SYC5188%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Aa4a19fd944ad056bedce9d25e345cece, accessed 16/10/2023, pp. 48-49.
51 Brian McGleenon, South China Sea: US Praises UK as Allies Prepare to Take Action against Beijing, Express.co.uk, 22/9/ 2020, available at https://www.express.co.uk/news/world/1338733/south-china- sea-us-uk-royal-navy-hms-queen-elizabeth-world-war-3, accessed 16/10/2023.
52 Donnelly, South China Sea Dispute SPREADS to Mekong River, op.cit.
53 Ibid.
54 Kuehner, China's Encounter with the West, op.cit.
55 Phillic Wegmann, Before Trump, US Sold Taiwan More than US $30 Billion in Weapons, Washington Examiner, 5/11/2016, available at https://www.washingtonexaminer.com/before-trump-us-sold-taiwan-more-than-30-billion-in-weapons, accessed 3/1/2024.
56 Global Firepower, 2023 United States Military Strength, 12/4/2023, available at https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=united-states-of-america, accessed 29/11/2023.
57 Lauren Kahn, AUKUS Explained: How Will the Trilateral Pact Shape Indo-Pacific Security?, Council on Foreign Relations, 12/6/2023, available at https://www.cfr.org/in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security, accessed 19/12/2023.
58 Sky News, 14/3/2023, Aukus nuclear submarine deal will help 'keep oceans free', says Rishi Sunak, available at https://news.sky.com/story/aukus-nuclear-submarine-deal-will-help-keep-oceans-free-says-rishi-sunak-12833271, accessed 19/12/2023.
59 محمد المنشاوي، الجزيرة، الانتشار العسكري الأميركي عبر العالم.. أين وكيف ولماذا وبأي كلفة؟، 16/4/2021، متوافر على الموقع الانتشار العسكري الأميركي عبر العالم.. أين وكيف ولماذا وبأي كلفة؟ | أخبار | الجزيرة نت،(aljazeera.net)، الدخول 12/11/2023.
60 Miaojung Lin, Chris Horton, A New Belt and Road? US, Taiwan Hook up to Counter China's Effort, Al Jazeera, 27/11/ 2020, available at https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/27/a-new-belt-and-road-us-taiwan-hook-up-to-counter-chinas-effort, accessed 16/10/2023.
Euronews61، قمة مجموعة العشرين تختتم أعمالها في نيودلهي وتباين مواقف القادة بشأن نتائجها، مرجع سبق ذكره.
62 الإمارات 71، أردوغان: لن يكون هناك ممر "بين الهند وأروبا" من دون تركيا، 11-09-2023، متوافر على الموقع أردوغان: لن يكون هناك ممر "بين الهند وأروبا" من دون تركيا (uae71.com)، الدخول 1/2/2024.
63 Steve Liesman, Trade War Losses for the U.S. and China Grow into the Tens of Billions of Dollars, CNBC, 5/11/2019, available at www.cnbc.com/2019/11/05/trade-losses-for-the-us-china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm, accessed 19/12/2023.
64 Ibid.
65 CNN العربية، جو بايدن في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: "أنا عند كلمتي.. أميركا عادت"، 19/2/2023، متوافر على الموقع جو بايدن في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: "أنا عند كلمتي.. أميركا عادت " - CNN Arabic، الدخول 1/5/2024.
66 Zhuoran Li, The Future of the China-US Chip War, The diplomat, 2/3/2023, available at https://thediplomat.com/2023/03/the-future-of-the-china-us-chip-war/, accessed 14/1/2024.
67 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, US Hegemony and Its Perils, February 2023, available at https://www.mfa.gov.cn/eng/wjbxw/202302/t20230220_11027664.html, accessed 28/11/2023.
68 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, The Global Security Initiative Concept Paper, 21/2/2023, available at https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202302/t20230221_11028348.html,
accessed 28/11/2023.
69 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis, 21/2/2023, available at https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html, accessed 28/11/2023.
70 The White House, National Security Strategy 2022, op.cit., p.27.
U.S. – China Relations: From Cooperation to Competition, then to Cautious Stability
This study examines the cooperation relations between the United States, the established great power, and China, the rising great power. It explores the transition of this relationship into competition and highlights its key axes. The study concludes that the two great powers have developed strategies and utilized their immense capabilities to compete, after a period of weakened cooperation since 2008, fading away completely in 2017, when the administration of former US President Donald Trump officially announced the beginning of a new era of US-China rivalry.
Moreover, the increasing competition between the United States and China has raised concerns about the possibility of a confrontation between the two powers due to a series of factors such as growing military tensions, economic competition, and ideological divergences. The United States seeks to enhance its military presence in the Indian Ocean and Pacific regions and to form alliances with regional partners, while China seeks to expand its military footprint and pursue ambitious infrastructure projects such as the Belt and Road initiative. Technological competition is also a key aspect of the interaction between the two countries for decades to come, perhaps even beyond 2050. The current era shows a growing shift towards an environment where technological leadership is the primary driver of political influence and economic power, in addition to being a crucial determinant of military strength.
Les relations sino-américaines: des coopérations à la rivalité vers une stabilité prudente
Cette étude examine les relations de coopération entre les États-Unis, grande puissance établie, et la Chine, grande puissance montante. Elle explore la transition de cette relation vers la compétition, tout en mettant en lumière ses principaux axes. L'étude conclut que les deux grandes puissances ont élaboré des stratégies et utilisé leurs énormes capacités pour rivaliser, après une période de coopération affaiblie depuis 2008, qui s'est complètement effacée en 2017, lorsque l'administration de l'ancien président américain Donald Trump a officiellement annoncé le début d'une nouvelle ère de rivalité sino-américaine.
De plus, la compétition croissante entre les États-Unis et la Chine a suscité des craintes quant à la possibilité d'une confrontation entre les deux puissances en raison d'une série de facteurs tels que les tensions militaires croissantes, la compétition économique et les divergences idéologiques. Les États-Unis cherchent à renforcer leur présence militaire dans les régions de l'océan Indien et du Pacifique et à former des alliances avec des partenaires régionaux, tandis que la Chine cherche à étendre son empreinte militaire et à poursuivre des projets d'infrastructures ambitieux tels que l'initiative Belt and Road. La compétition technologique est également un aspect clé de l'interaction entre les deux pays pour les décennies à venir, peut-être même après 2050. L'ère actuelle montre un changement croissant vers un environnement où le leadership technologique est le principal moteur de l'influence politique et de la puissance économique, en plus d'être un facteur déterminant de la puissance militaire.