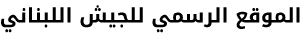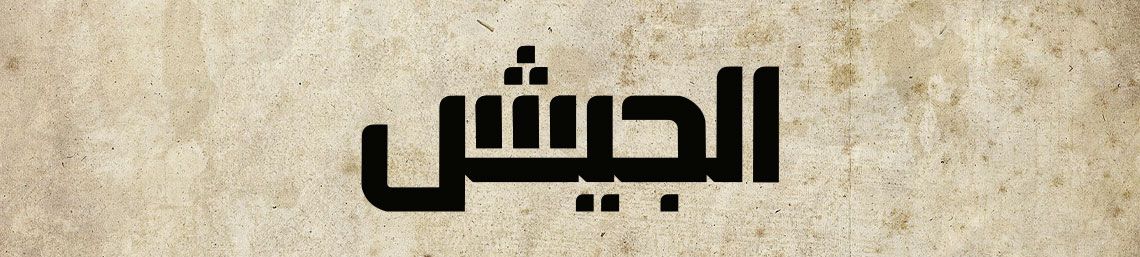- En
- Fr
- عربي
دراسات
يشير تغيّر المناخ إلى التحوّلات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، تكون أسبابه إمّا طبيعيّة بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانيّة الكبيرة، أو الأنشطة البشريّة والاقتصاديّة. وقد دخل العالم في السنوات الأخيرة مرحلة طوارئ تتطلب حلولًا منسقة من قبل الحكومات والمجتمعات حول العالم، وتعاونًا دوليًّا للتحرّك نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تفيد التقديرات أنّ العالم سيحتاج خلال العقد القادم إلى حشد تريليونات الدولارات لتأمين مقوّمات الصمود من المياه والغذاء والطاقة النظيفة والحماية من الكوارث وغيرها. لكن، في ظلّ الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد-19 وتداعيات عدم الاستقرار الجيو - سياسي وارتفاع معدلات التضخّم والاستدانة، ومع اتساع فجوة التمويل لا سيّما لدى الدول النامية، تعمل المنظمات الدوليّة مثل البنك الدولي وبنوك وصناديق التنمية على مساندة البلدان للتحوّل نحو مسارات إنتاج واستهلاك مستدامة، تمكّنها من بناء اقتصادات مراعية للمناخ وشاملة للجميع. ومع تزايد الحاجة لتمويل الأنشطة المناخية، تُطرح أسئلة كثيرة حول مصادر التمويل ودور الحكومات في قيادة التغيير نحو أجندات وطنية مراعية للمناخ، إذ برزت مفاهيم جديدة تتناول التمويل الأخضر. فما هو هذا التمويل؟ وما علاقة الماليّة العامة به؟ وهل يأتي بالحلول الفعّالة للتصدي لتحديات المناخ؟ وكيف يمكن للبنان أن يستفيد من النهج العالمي الجديد لحماية البيئة والنظم الإيكولوجيّة وتحسين فرص الاقتصاد الأخضر؟ اقتصاد يؤمَل أن يكون أكثر ازدهارًا واستدامة.
أهداف عالمية وإجراءات لمكافحة تغيّر المناخ
في العام 2015، التزمت الحكومات حول العالم أجندة التنمية المستدامة لأفق العام 2030. ومن بين أهدافها السبعة عشر، يدعو الهدف 13 إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيّر المناخ وآثاره. تتميّز أجندة 2030 بأنّ جميع أهدافها مترابطة، فلا يمكن تحقيق التقدّم في العمل المناخي مثلًا من دون الإسراع بتحقيق الهدف 7 المتعلّق بتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، أو بتحقيق الهدف 12 حول الاستهلاك والإنتاج المستدامَين. ولتحقيق هذا الالتزام العالمي، تبنّت 197 دولة اتفاق باريس لإيجاد المقاربات والنشاطات المناسبة للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ومن زيادة درجة الحرارة العالمية بحلول العام 2100 إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحدّ من الزيادة إلى 1.5 درجة.
يحتاج التقدم على هذه المسارات والانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة خالٍ من الكربون إلى استثمارات كبيرة قدّر منتدى الاقتصاد العالمي قيمتها بحوالى 13.5 تريليون دولار بحلول العام 2050، معظمها في قطاعات الإنتاج والطاقة والنقل. وعليه، يتعيّن على البلدان استثمار 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لكي تستطيع تعزيز صمودها في مواجهة تغيّر المناخ وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول العام 2030.
تخصص الدول المتقدّمة سنويًا حوالى 100 مليار دولار من المساعدات الإنمائيّة للدول النامية. لكنّ بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للعام 2020 تشير إلى تفاوتٍ كبير في تخصيص هذه الموارد المالية بين الدول؛ إذ إنّ 8% فقط من أصل 83.3 مليار دولار خُصص للبلدان منخفضة الدخل ونحو الربع لأفريقيا، على الرغم من تعاظم التحديات المناخية والتنموية لديها. إلى ذلك، تعاني العديد من البلدان النامية أعباء الدين العام، وتواجه خيارات صعبة لكيفية توزيع الموارد بين تمويل التكيّف مع المناخ وتحسين الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والنقل.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتطلّب تحديات المناخ اهتمامًا عاجلًا وجهودًا متضافرة للتخفيف من الآثار السلبية للمخاطر الأكثر تهديدًا للبيئة والإنسان، وهي:
- ندرة المياه بسبب محدودية موارد المياه العذبة، وارتفاع معدلات النمو السكاني، والنشاط الزراعي، علمًا أنّ هذه المشكلة تتفاقم بسبب تغيّر أنماط هطول الأمطار وتسارع التبخّر.
- ارتفاع درجات الحرارة وما يسببه من تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان والزراعة والنظم البيئية.
- ارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية والذي يؤدي إلى تآكل السواحل، وتسرّب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة، وزيادة مخاطر الفيضانات والعواصف، وبالتالي تهديد سبل العيش والبنى التحتية.
- التصحّر وتدهور الأراضي الذي يؤثر سلبًا على الزراعة والأمن الغذائي ويؤدي إلى توسّع المناطق القاحلة فيجعل الأراضي أقل ملاءمة للزراعة.
- الطلب على الطاقة الذي يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومشكلة تغيّر المناخ العالمي.
- الزراعة والأمن الغذائي، إذ تؤدي أنماط هطول الأمطار وزيادة حالات الجفاف وندرة المياه إلى تراجع المحاصيل.
- فقدان التنوّع البيولوجي وتهديد النظم البيئية الفريدة في المنطقة، ما يؤدي إلى هجرة الحيوانات وتعريض أنواع نباتية وحيوانية مختلفة لخطر الانقراض.
- وأخيرًا النزوح والهجرة البشرية وما يرافقهما من تحديات اجتماعية وأمنيّة وسياسيّة.
ويبقى السؤال الملحّ، كيف سيتم إيجاد التمويل، ومن أيّ مصادر وبأي وسائل ووسائط؟
المال وتحديات المناخ
برز مؤخرًا مفهوم التمويل الأخضر كعنصر حاسم في التصدّي للتحديات البيئيّة العالميّة وتعزيز فرص التنمية المستدامة. وهو يشمل المنتجات والخدمات والاستثمارات الماليّة التي تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات ذات الآثار البيئيّة الإيجابيّة. يواكب مفهوم التمويل الأخضر التحولات التي تفرضها التحديات سابقة الذكر وتوجّهات المجتمع الدولي حول تخصيص رأس المال للأنشطة التي تساهم في الاستدامة البيئية، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الموفّرة للطاقة، والزراعة المستدامة. ويتمثل أحد الجوانب المهمة لهذا التحوّل في التكامل المتزايد للمعايير البيئية والاجتماعية مع قرارات الاستثمار، سواء كانت استثمارات خاصّة أم عامّة، إذ بات المستثمرون يأخذون في الاعتبار بشكل متزايد التأثير البيئي لمحافظهم الاستثماريّة ويبحثون عن الفرص التي تتوافق مع أهداف الاستدامة. وقد أدى هذا الاتجاه إلى انتشار السندات الخضراء، والقروض الخضراء، وغير ذلك من الأدوات الماليّة المصمّمة خصّيصًا لتمويل المشاريع المفيدة بيئيًا مثل مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والصناعات، والحلول المستدامة لإدارة النفايات، ومشاريع البنية التحتية الخضراء للتكيّف مع تغيّر المناخ.
ومع تقدّم تطويع المفهوم لغرض الاستثمار العام، تبيّن أنّه من غير الممكن وضع وتنفيذ سياسات ذكيّة وخضراء من دون العودة إلى المؤسسات العامة، وتضمين هذه المقاربات في منهجيّة عملها وطريقة وضع موازناتها، وكذلك خططها لشراء المواد والأشغال والخدمات، وفي أنظمة الإدارة التي تعتمدها. والمعروف أنّ تغيُّر المناخ يتأثّر بكل إجراء تتخذه الحكومات، وبالتالي فإنّ الاستراتيجيات الحكومية والخطط التمويليّة طويلة الأمد تتيح، في حال اعتمدت منهجيّات التمويل الأخضر، فرصًا ثمينة لمواجهة تحديات المناخ بشكل خاص ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أوسع.
من هذا المنطلق يكون للماليّة العامة دور أساس في توجيه وتخصيص الموارد اللازمة لمواكبة العمل المناخي، وبذلك تستطيع وزارات المال أن تكون رأس الحربة في دفع عجلة التحوّل إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيّف.
عالميًا، وانطلاقًا من إدراك الدور التحوّلي (transformative power) للماليّة العامة، اجتمع وزراء المال في العام 2018 في تحالف سُمّي بـ «تحالف وزراء الماليّة للعمل المناخي»، وهم يعملون منذ ذلك الحين لتطوير مفاهيم التمويل الأخضر ولكي تصبح الأدوات التي تتيحها الماليّة العامة من ضرائب وشراء عام واستثمار عام وغيرها، في صلب التوجهات الحكومية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بحسب مبادئ أصبحت تُعرف بـ مبادئ هلسنكي.
هذا وتساهم اقتصادات 73 بلدًا عضوًا في التحالف بـ 65% من إجمالي الناتج المحلي العالمي (البنك الدولي، 2020) وتنتج 35% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.
أدوات المالية العامة التي يمكن أن تُحدث فرقًا
تتألف إدارة الماليّة العامة من عدة مكوّنات من شأنها إحداث الفرق في حال تمّ دمجها في الالتزامات الوطنيّة للعمل من أجل المناخ، وهي:
1. الموازنة العامة الخضراء: وهي الأداة الأساس التي إذا أُعدّت بمنهجيّة خضراء، تسمح بتخصيص فعّال للموارد، وتُتيح للحكومات تقييم النسبة المئوية للإنفاق على الأنشطة المتصلة بتغيّر المناخ من إجمالي الناتج المحلي، وتحديد مصادر هذا الإنفاق.
2. الحوافز المالية الخضراء: وهي أدوات تسمح بدمج اعتبارات المناخ في حزم التحفيز الاقتصادي، كتلك التي استعملتها فرنسا مثلًا خلال جائحة كوفيد-19 لتحفيز صناعات السيارات على التحوّل نحو إنتاج الكهربائيّة منها.
3. إصلاح سياسات الدعم: خصوصًا تلك الرامية إلى إلغاء الحوافز الضارة بالبيئة (مثل دعم الوقود) وتطبيق تسعير الكربون الذي يمكن أن يُؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا على القطاع الخاص وسلوك المستهلكين. وقد ثبت في عدة بلدان أنّ هذه الإصلاحات تشجّع تدفُّق الاستثمارات نحو البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء.
4. أدوات الاستثمار العام الأخضر: ويتضمّن ذلك استحداث أدوات ماليّة جديدة مثل السندات الخضراء لتمويل المشاريع الجديدة والقائمة التي يمكن من خلالها التصدي لتغيّر المناخ والحفاظ على البيئة.
5. الشراء العام الأخضر: وهو أحد أكثر أدوات السياسة الماليّة أثرًا في تحفيز الابتكار واعتماد السلع والخدمات والأشغال المراعية لاعتبارات المناخ والانتقال نحو أنماط استهلاك وإنتاج مستدام من قبل الحكومات التي هي اللاعب الأكبر في السوق، ذلك أنّ الشراء العام يشكل 20 إلى 30% من النفقات العامة. وفي هذا الإطار، لا يكفي أن تكون التشريعات ملائمة، بل المطلوب اعتماد المعايير البيئية في دفاتر الشروط، والعلامات البيئية وتكلفة دورة الحياة للمنتج (Life cycle costing-LCC) عند تنفيذ عمليات شراء والتدريب التقني للمسؤولين وقادة المؤسسات على استراتيجيّات الشراء الأخضر وتقنيّاته.
إضافةً إلى ما سبق، هناك قطاعان محوريان للتمويل الأخضر؛ الأول يتعلّق بالشركات المملوكة من الدولة كشركات الكهرباء مثلًا، وضرورة مساندتها في توفير بصمة كربونية منخفضة وتحفيز انتقالها نحو الاستثمارات الخضراء، وتشجيعها على تخصيص أهداف محدّدة للعمل المناخي ضمن نشاطها القطاعي. أما القطاع الثاني فهو المتعلّق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ من المطلوب والممكن اقتراح تشريعات تشترط أن تعتمد المعايير البيئية، وأن يتم تقييم المشاريع بناءً على المخاطر المتصلة بتغيّر المناخ والكوارث وآثارها على البيئة.
أين لبنان اليوم من هذا المسار العالمي؟ وهل نحن في خطر أن يفوتنا قطار التنمية المستدامة؟
حدّد تقرير المناخ والتنمية الخاص بلبنان، الذي أطلقه البنك الدولي في 13 أذار 2024، المخاطر المناخية التي تواجه لبنان وأثرها المحتمل على مسار النمو والتنمية فيه؛ مسار يعاني انكماشًا اقتصاديًا متواصلًا للسنة الخامسة على التوالي، وتراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار في العام 2018 إلى 23 مليار دولار في العام 2021.
في التقرير، يأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد اليمن من بين الدول الأقل استعدادًا لمواجهة تغيّر المناخ في المنطقة، ويحتلّ المركز 161 من بين 192 بلدًا على مستوى العالم في الجهوزية لمواجهة تغيرات المناخ. وقد حذّر التقرير من أن عدم الجهوزيّة سيؤدي إلى تقليص إمكانات النمو بنسبة قد تبلغ 2% سنويًا بحلول العام 2040، وإلى إعاقة تقديم الخدمات الأساسيّة، لا سيّما في قطاع المياه إذ من المتوقع أن يزيد شحّ المياه بنسبة 9% مع حلول العام المذكور.
التحديات الهائلة تحمل معها فرصًا كبيرة، وهذه الفرص تكمن في أربع قطاعات يعتبرها التقرير محرّكًا للتعافي وهي: الطاقة، المياه، النقل، والنفايات الصلبة التي تحتاج إلى تمويل بقيمة 770 مليون دولار أميركي على المدى القصير (2024-2026)، وإلى استثمارات بقيمة نحو 7.6 مليارات دولار أميركي خلال السنوات 2024 - 2030.
في حال اختار لبنان سيناريو «التعافي» الاقتصادي الذي يفترض تبنّي إصلاحات ماليّة هيكليّة، ستنخفض القيود على التمويل ما يسمح بزيادة الحيّز المتاح في الماليّة العامة للإنفاق على هذه القطاعات وخلق فرص عمل مرتبطة بها. أمّا في سيناريو «المراوحة»، أي التأخّر في تنفيذ الإصلاحات، فسيخسر لبنان مرتين: أولاً، خسارة فرص التمويل المتاحة من الماليّة العامة ومن القطاع الخاص، وثانيًا الخسائر القطاعية السنويّة بسبب تغيّر المناخ ومنها ما يقدّر في الزراعة مثلًا بـ 250 مليون دولار أميركي.
بناءً على ما تقدّم، يصبح واضحًا كم هو ضروري للبنان اعتماد النهج العالمي الجديد في دمج الأولويات المتعلقة بالتصدي لتحديات المناخ ضمن إصلاحات المالية العامة الهيكلية. يكمن ذلك في مجالات الموازنة من خلال تخصيص نفقات وإيرادات لأهداف حماية البيئة وتوسيم الموازنة budget tagging ورفع الدعم عن المواد المضرّة للبيئة. ويكون أيضًا باعتماد الشراء العام الأخضر والمستدام كما نصّ عليه قانون الشراء العام 244/2021 والذي يحتاج إلى وضع معايير محددة، مثلًا معايير لخفض مستوى الكربون في شراء السلع والخدمات أو توفير الطاقة في مشاريع البنى التحتية وتسيير المرافق العامة. الفرص متاحة أيضًا في الإصلاحات الضريبيّة التي يمكن أن تعتمد النهج الأخضر، كذلك في الأطر المنوي استحداثها في إدارة الاستثمارات العامة، والمعايير الإصلاحيّة التي يُنتظر أن تُعتمد في إعادة تعويم الشركات المملوكة من الدولة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن العوامل المساندة، طرح الأولويات وإشراك الجهات المعنية كافة في نقاش وطني جدّي ورؤيوي، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتعزيز القدرات على تصميم وتنفيذ إصلاحات المالية العامة، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي والدولي لتطبيق الممارسات الجيدة في دمج أهداف تغيّر المناخ في إصلاح المالية العامة.
لا يصحّ أن يبقى لبنان، بمؤسساته الحكومية وبقطاعه الخاص، غائباً عن هذا المسار الدولي فيخسر فرص التمويل المُتاحة لمواجهة هذه التحديات، ويفوته أيضًا قطار التنمية المستدامة.
المراجع
1. البنك الدولي، الاستثمار الحيوي في القطاعات الرئيسية يساعد لبنان في التخفيف من آثار تغير المناخ على النمو وفي الاستعداد للتحول الأخضر، آذار 2024
2. البنك الدولي،
3. تقرير العربية حول كوب 28، حصيلة عالمية لاتفاق باريس للمناخ بعد 8 سنوات، تشرين الثاني 2023
4. البنك الدولي، وزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهم الارتقاء بالعمل المناخي إلى المستوى التالي، 2022
5. البنك الدولي، تمويل التحول المناخي: اقتصادات المستقبل الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود، نيسان 2022