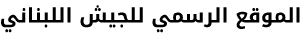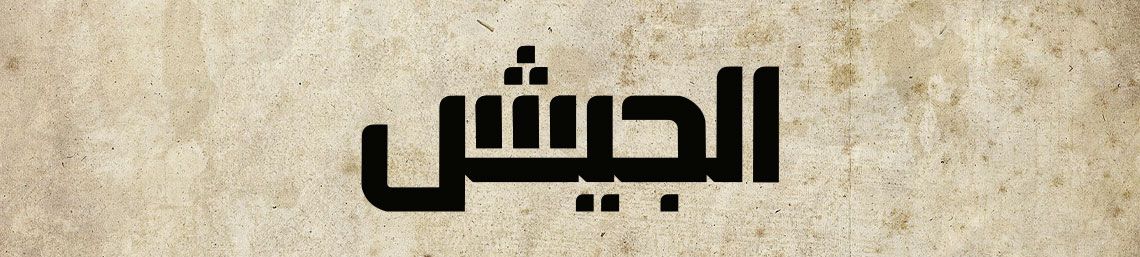- En
- Fr
- عربي
قطاعات إنتاجية
جودة عالية وقدرة تنافسية ولكن...
بدأت تربية النحل في لبنان بمثابة هواية لدى معظم المربّين، لكنّ هذا الواقع تغيّر في العقود الأخيرة. فقد شهد قطاع النحل في لبنان نموًّا متسارعًا منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، وازداد هذا النمو بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية وخلال جائحة كورونا، إذ تفرّغ الكثيرون للعمل في هذا المجال الذي بات مهنة تعود عليهم بمردود كبير، خصوصًا بعد استقدام المعدّات والتقنيّات الجديدة.
إنّ أهم شروط تربية النحل هو توافر البيئة المناسبة، ولبنان واحد من أفضل هذه البيئات، لكن في المقابل ثمة عديد من المشكلات التي تواجه النحّالين.
يُنتج النحالون اللبنانيون ما يُقدّر بـ 1500 طن من العسل سنويًا، وتتغير هذه الكمية بحسب معدل الأمطار ومقدار توافر المراعي البرية. يغطي هذا الإنتاج جزءًا مهمًا من حاجة السوق المحليّة إلى العسل وحبوب اللقاح Grains de pollen، ويُصدّر قسم منه إلى الخارج. فالعسل اللبناني يتميّز بجودة عالية وقدرة تنافسيّة بحسب ما يوضح نقيب مربّي النحل في لبنان جورج حنا.
تطوّر القطاع منذ ستينيات القرن الماضي
يكشف النقيب حنا أن «لا وجود لإحصاءات حول ما كان عليه عدد قفران النحل في لبنان مطلع القرن الماضي وخلال فترة الانتداب الفرنسي. لكن في بداية الستينيات قُدِّر العدد بحوالى 50 ألف خليّة، وتطوّر في بداية السبعينيات ليلامس الـ70 ألفًا، موزّعة بين قفران بلديّة متفاوتة الأحجام وأخرى حديثة «لونغستروت». وقد قامت وزارة الزراعة بإحصاء النحّالين وعدد قفرانهم، كما تمّ ترقيم القفران وإعطاء رمز لكلّ نحّال ولكلّ قضاء، الأمر الذي سهّل عملية توزيع الأدوية ومراقبة تطوّر القطاع. أمّا آخر إحصاء رسمي أجرته وزارة الزراعة فكان في العام 2021 وأظهر أنّ هناك 470 ألف خلية».
بحسب حنا، يمكن تقسيم النحالين إلى 3 فئات: «محترفون يملكون أكثر من 250 قفيرًا ويعوّلون بمداخيلهم على إنتاج القفير (عسل، حبوب اللقاح، الدنج Propolis وهي المادة الصمغية التي يجمعها النحل من الأشجار ويستعملها لتعقيم الخلية وطلائها وإقفال الصكوك)، ونحّالون يجمعون بين النحل وعمل آخر وأعداد قفرانهم أقل من 250 قفيرًا، ونحّالون مبتدئون أو هواة وعدد قفرانهم دون الـ50 قفيرًا».
من هدية إلى مشروع
يروي لنا أمين سر نقابة النحالين يوسف نذر حكايته مع تربية النحل التي بدأت منذ 8 سنوات، فهو كان يعمل في الكويت ويحمل معه العسل اللبناني إليها كهدية ثمينة يقدّمها للأصدقاء هناك، لذلك كانت تربية النحل أوّل ما فكّر به عندما عاد إلى لبنان. بدأ بـ10 قفران، وخلال فترة قصيرة وصل العدد إلى 180 قفيرًا، ليصبح المشروع عملًا عائليًّا تساعده فيه زوجته التي استهوتها هذه المهنة أيضًا. وامتدّت تجارته إلى خارج الحدود فبات يصدّر جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى الكويت أولًا، ثمّ إلى الشركات الطبية في سويسرا التي يزوّدها بسمّ النحل (وهو مادة تفرزها الغدد السمّية عند النحلة خلال اللسع، وتُعتبر علاجًا للكثير من الأمراض).
يشدّد نذر على ضرورة وجود علاقة تكاملية بين المزارع والنحال، لأنّ النحلة تستفيد من الثروة الشجرية لتقوم بعملية التلقيح. ورأى أنّ هناك ضرورة قصوى لمعالجة مرض «الفاروا» Varroa الذي يصيب النحل ويفتك به فيخفّض نسبة الإنتاج، وذلك من خلال استعمال الأدوية الفعالة التي لا تترك ترسبات في العسل.
الوراثة والدراسة
بدوره، يخبرنا العضو في نقابة النحالين أمال وهيبه (مربّي نحل ومتخصّص بالتدريب) قصته مع تربية النحل، فيقول: «بدأت بتربية النحل سنة 1979 خلال الحرب، وقد انتقلت هذه المهنة إليّ بالوراثة من جدّي الذي كان يربّي النحل على الطريقة التقليدية، ثمّ أبي، وأيضًا خالي الذي درس أصولها مع الآباء اليسوعيين. نقلت الخلايا إلى قفران حديثة، ثم رحت أقرأ وأطبّق أصول تكاثر الخلايا وتقسيمها... وعندما تخطى العدد 30 خليّة اشتريت أجهزة الفرز والتنضيج، ثمّ بعد 3 سنوات انضمّ إليّ أخي وأحد الأصدقاء، فأصبحنا 3 نحّالين نعمل معًا.
ويضيف وهيبه: «بلغ عدد الخلايا المنتجة حوالى سبعمئة والإنتاج يفوق السبعة أطنان سنويًا. وقد تابعت دورات عدّة حول أمراض النحل وتقنيّات التربية الحديثة وطرق التأصيل ما رفع كفاءتنا في العمل... ومنذ أواخر الثمانينيات انتسبت إلى جمعية حماية وتنمية النحل (APIS) وترأستها. وهي تنظّم دورات تدريبية متنوّعة وتُصدِر مجلّة متخصّصة بتربية النحل. وحاليًا، أنا منتسب إلى نقابة النحّالين في لبنان وعضو في الهيئة الإدارية وأعمل معها في سبيل تنظيم القطاع».
وأوضح وهيبه أنّه يقوم بتسويق قسم من العسل في السوق المحليّة بينما يُصدّر القسم الآخر. ويقول: «بين العامين 1990 و2004 كنا نصدّر كلّ سنة بين 3 و6 أطنان عسل إلى اليابان، وصدّرنا أيضًا إلى الكويت، وبكمّيات قليلة إلى بعض الدول العربية والأوروبية. حاليًا، نركّز على السوق المحلية لأنّ الطلب على العسل ازداد ما أدى إلى ارتفاع سعره، كما أنّ الشركة المستوردة في اليابان أقفلت. لكن لا بد من الإشارة إلى أنّ هذا القطاع استعاد نشاطه التصديري بعد أزمة كورونا بسبب زيادة نسبة العاملين فيه».
المشكلات والمعوقات
لدى سؤالنا عن الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، يُشير النقيب حنا أولًا إلى وجوب التنسيق بين النحّالين القدامى والوافدين الجدد إلى القطاع لتطوير كفاءتهم المهنية ومهاراتهم التي يفترض أن يتقنوها لتساعدهم على زيادة الإنتاج وحماية قفرانهم. كما يلفت إلى أنّ انحسار البيئة الزراعية والحرجية وتلوّثها يضع تربية النحل أمام مشكلة مهمة، فالمزارعون يقومون برشّ بساتينهم بالمبيدات السامة التي تؤذي النحل وتؤثر على إنتاج العسل من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة مربّي النحل. يُضاف إلى ذلك التنافس على المراعي وعشوائية الانتشار.
ويوضح أنّ الإفراط في الرعي وسوء التغذية يضعفان المناعة عند النحل ويسهّل انتشار الأمراض ويخفّض جودة الإنتاج. فالنحل يعاني أمراضًا عديدة، ومع ارتفاع عدد القفران والإفراط بالرعي واستيراد السلالات المتنوعة ازدادت الأمراض وأصبحت أكثر انتشارًا.
تُعدّ المحافظة على نوعية الإنتاج مشكلة بحد ذاتها، فقد وضعت مؤسّسة ليبنور Libnor مواصفات العسل، وهي مجموعة مؤشّرات يجب أن تتوافر كي يُصنّف المنتج كعسل جيد. في هذا السياق، يشير حنا إلى أنّه يوجد في الأسواق أحيانًا عسل مستورد ينافس العسل اللبناني الجيّد، لكن إخضاعه للفحوصات اللازمة يكشف عدم تمتعه بالمواصفات المطلوبة. لذلك، يجب إلزام النحّال بالفحوصات قبل التسويق واعتماد فحص عيّنات معينة للحدّ من الغشّ، الأمر الذي يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاقتصاد والصحة ويكفل جودة العسل اللبناني ويحافظ بالتالي على قدرته التنافسية.
إلى ذلك، ثمة مشكلة على صعيد استيراد الملكات، إذ إنّ الكثير منها لا يتّصف بالجودة أو لا يكون من النوعية المطلوبة، مع العلم أنّ استمرار الاستيراد بكثافة يغيّر المواصفات الجينية للنحلة المحلية، ما يؤثر في كمية العسل التي ينتجها النحل.
كما يرى النقيب حنا أنّنا نفتقر إلى الأبحاث العلمية المحلية. وبالتالي إذا أراد النحّال تطوير عمله لجأ إلى ملاحظاته وتجربته العملية أو الأبحاث الصادرة في الدول الغربية. لذلك، يجب أن تعمل مؤسسات الأبحاث العلمية على إيلاء قطاع النحل مركزًا أساسيًا في دراساتها وأبحاثها وتجاربها التطبيقية.
يستحق قطاع تربية النحل في لبنان الدعم والاهتمام من المعنيين، فالعسل ليس مجرد غذاء فاخر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بل هو دواء أيضًا. وإذا كانت جهود النحالين على مر السنين قد أثمرت عسلًا لبنانيًا يتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق الخارجية، فمن الضروري دعم هذه الجهود ومساندتها لتعزيز قطاع واعد، إن على صعيد تلبية حاجة السوق المحلية أو على صعيد التصدير إلى الخارج.
مشروع قانون
أمام توسّع القطاع وتنوّع منتجاته وارتباط أكثر من 6 آلاف عائلة بمداخيله، تشكّلت نقابة النحّالين وتمّ تفعيلها من جديد سنة 2019
وقد صاغت النقابة مشروعًا ينظّم قطاع النحل في لبنان ويتناول ضمن بنوده العناوين الآتية:
- تنظيم العلاقة بين النحّالين وبقيّة القطاعات الزراعية.
- عقلنة توزّع النحل وترحيله.
- المهارات المهنية الأساسية لتربية النحل.
- خصائص العسل اللبناني وبقيّة منتجات القفير.
- اختيار مواقع المناحل وكيفيّة حمايتها.
- النحلة المحلية وكيفيّة حمايتها وتأصيلها ومسألة التلوّث الجيني.
- الأمراض وحماية المناحل.
- تنظيم استيراد العسل والشمع وغيرهما من منتجات القفير.
- شروط إنتاج العسل وتسويقه وتصديره.
وتعمل النقابة حاليًا مع الجهات المعنية على تحويل هذا المشروع إلى قانون يصدره المجلس النيابي وتشرف الأجهزة المختصّة والنقابة على تطبيقه، ويلتزم به النحّالون والمتعاملون معهم.
أنواع العسل اللبناني
هناك 3 أنواع من العسل في لبنان:
عسل زهر الليمون.
عسل الشوكيات أو العسل الجبلي.
عسل السنديان الأسود أو ما يُعرف بعسل الندوة العسلية.
اعتقاد خاطئ
هناك اعتقاد خاطئ مفاده أنّ تبلور العسل أو ما يُعرف بظاهرة تجمُّد العسل دليل على جودته أو غشّه. فباستثناء العسل الذي يجمعه النحل من مخلفات حشرة المنّ (عسل السنديان)، كل أنواع العسل قابلة للتبلور عند انخفاض درجة الحرارة، ذلك أنّه محلول مُشبَع جدًا بالسكريات، وتسخينه لمنع تبلوره يُفقده قيمته الغذائية الأصلية. ولا يمكن معرفة العسل المغشوش إلا عبر الفحص المخبري الذي يكشف نسبة الغلوكوز والساكاروز فيه.