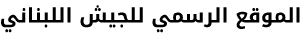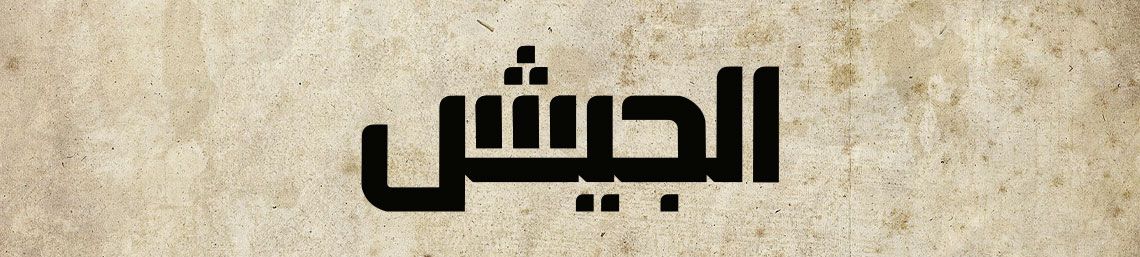- En
- Fr
- عربي
تحت الضوء
إذا كان قانون نيوتن الثالث الذي وضعه عالم الفيزياء والرياضيات الإنجليزي إسحاق نيوتن، أو كما يُسمّى أيضًا بقانون ”الفعل وردّ الفعل“، ينصّ على أنّ لكل فعل ردّ فعل مساويًا له في المقدار ومعاكسًا له في الاتجاه، فإنّ ما يمكن تطبيقه في علم الفيزياء لا يصلح بالضرورة في الصراعات والعلاقات بين الدول القائمة على المصالح والمرتبطة بتغيّرات العوامل والظروف. انطلاقًا من ذلك، وفي محاولةٍ للملاءمة بين المصالح والردود، قد يلجأ بعض الأطراف إلى القيام بردّ فعل غير مساوٍ في المقدار للفعل الذي تعرّضت له، أو ربما عدم القيام بأي ردّ.
تنصّ المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنّه «ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلّحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تُبلَّغ إلى المجلس فورًا. ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال في ما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.» من هنا تمارس الدول حقها في الدفاع عن النفس استنادًا إلى المادة 51، وتتماشى عملياتها العسكرية للردّ على أي هجوم أو انتهاك لسيادتها مع جوهر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
فالخطر بالنسبة إلى الدول، إذا لم تَقُم بردّ فعل، هو أن تبدو بصورة الضعيف والمردوع بالقوة العسكرية للطرف الآخر، ذلك أنّ الضعف يجلب العدوان، كما يقول هنري كيسنجر. ومن الصعب في هذه الحالة وقف الجولات المتتالية من الردّ والردّ المضاد عندما تخشى الدول المعنية أن يُنظر إليها على أنّها ضعيفة إذا لم تستجب. من هنا، على الدول أن توحي دائمًا من خلال أفعالها أنّها قويّة وقادرة، باعتبار أنّ أي اعتداء سيُعتبر انتهاكًا للسيادة الوطنية وتجاوزًا للخطوط الحمر وبالتالي لن يمرّ من دون ردٍّ مناسب. وكان المفكر الفرنسي جان بودان من أبرز المنادين بسيادة الدولة، وقد عرض آراءه حول هذا الموضوع في عديدٍ من المؤلفات، وهو يرى أنّ السيادة هي المدماك الأساسي في بنيان الدولة، فلا دولة من دون سيادة.
الردّ ومفهوم الردع
يشكّل إدراك الدول للقدرات العسكريّة لدولة ما، عاملًا أساسيًّا في امتلاك قدرة الردع الاستراتيجي لهذه الدولة، أمّا فعاليّة هذا الردع فتتوقّف على قدرة هذه الدولة في إظهار قوتها والتأثير في إدراك، مفاهيم ومعرفة تلك الدول. بالتالي، تُعدّ المعلومات شرطًا أساسيًا لمضاعفة فاعلية الردع، إذ إنّ تطوير أحد الأطراف قدراته العسكرية والقتالية والعمل بالتوازي على تسليط الضوء على ذلك إعلاميًا عن طريق العروض العسكرية والمناورات أو حتى التصريحات، سيعزّز بلا شكّ من قدرات الردع لديه.
اعتُمدت نظرية الردع في استراتيجيات عديدٍ من الدول من أجل الحفاظ على أمنها القومي، كما أسهمت في تحقيق الأمن الجماعي عن طريق ردع الأطراف التي تحاول الإخلال بالأمن والاستقرار الدوليين. ويعتمد الردع على التأثير في قرار الخصم أو العدو المحتمل وإقناعه بأنّ تبعات قيامه بعملٍ عدائي تفوق بكثيرٍ المكاسب التي يمكن أن يحققها نتيجة هذا العمل. وفي سياق متصل، يُعرّفه الجنرال الفرنسي أندريه بوفر على أنّه «منع دولة معادية من اتخاذ قرار باستخدام قدراتها العسكرية، أو بصورة أشمل، منعها من العمل أو الردّ إزاء موقف معين عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تشكل تهديدًا كافيًا حيالها، وهو ما يسمّى بالردع عن طريق الترهيب أو التخويف بالعقاب، إذ يأخذ هذا التهديد (التأثير) شكلًا من أشكال الحرب النفسية.» من هنا يتبلور الترابط بين منطق الردّ ومفهوم الردع بوصفه عاملًا أساسيًا في حلقة الردّ والردّ المضاد، انطلاقًا من تأثيره الكبير في حجم هذا الردّ وفعاليته، أو في الإحجام عنه خوفًا من تداعياته وانعكاساته السلبية.
على هذا الأساس، يتطلب الردع إبلاغ العدو بطريقة حازمة بوجود إرادة وتصميم مؤكدَين على معاقبته والانتقام منه في حالة إصراره على الردّ، وكذلك إفهامه أنّ التكاليف والخسائر التي سيتكبّدها تتخطّى أي مكسب أو هدف يمكن بلوغه، وهذا هو أساس مفهوم الردع وجوهره. وفي حال استمرار مسلسل الردّ والردّ المضاد، ينتفي تلقائيًا الحديث عن من حقق مكاسب أكبر، لأنّ الخاسر الأول في هذه الحالة هو الردع الذي تزعزع وبات يواجه تحديًا مع انكشاف مكامن الضعف والثغرات لكلا الطرفين.
لعبة التوازن
لا شك في أن تعمَد الأطراف إلى الاحتفاظ بأوراقٍ مؤثرة لم تُستعمل بعد، فلا يمكن أن تطرح جميع ما لديها من أوراق عند أول مواجهة. فبعد كل ردّ، يفقد المُنفّذ زمام المبادرة ليصبح في وضع الدفاع بانتظار الردّ على الردّ، وتسيطر في هذه المرحلة حالة من الغموض والتوتر تؤججها حرب إعلامية ونفسية حول حق الرد وطبيعته وتوقيته ومكانه، وسط تحذيرات من انزلاق تدريجي إلى مواجهة مفتوحة. على هذا الأساس، طالما يتصرف طرفا النزاع بطريقة عقلانية، أي وفق حسابات دقيقة للتكاليف والأهداف المحقّقة، وطالما أنّ كلًا منهما يدرك مصلحته العليا في إطار لعبة التوازن، باعتبار أنّ قوة الضربة، أي الردّ، تحددها مصلحة البلاد، فإنهما سيمتنعان عن تجاوز حدود هذه اللعبة وبالتالي عدم الانزلاق إلى حرب شاملة. وفي إطار لعبة التوازن، وُضِعت أسس للتنظيم الدولي القادر على تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. في كتابه «الوسيط في القانون الدولي العام»، يوضح الدكتور محمد المجذوب أنّه «في القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهر كتّاب سبقوا عصرهم بالتفكير واستشراف المستقبل، وكان لأفكار هؤلاء ومشاريعهم تأثير في ملوك أوروبا الذين أنهكتهم الحروب المتلاحقة، ففضّلوا، بعد إعمال التفكير واستخلاص العِبر وتمحيص الحسابات، الأخذ بمبدأ التوازن بدلًا من الانغماس في الحروب. وقد حافظ مبدأ التوازن على السلام والهدوء في أوروبا لفترة زمنية لا بأس بها تمكّنت معظم الدول الضعيفة خلالها من حماية وجودها واستقلالها...». وترتكز هذه السياسة على فكرة أساسية، هي ضرورة توزيع القوى بين الدول بطريقةٍ تحقق التوازن في ما بينها وتضبط الأفعال وردود الأفعال، في ظل وجود قناعة ثابتة بعدم الإخلال بالتوازن القائم والمتفق عليه.
وفي لعبة التوازن هذه، ينبغي ضبط عملية الردّ والردّ المضاد إلى أقصى حدّ، لأنّ أي خلل في هذا المبدأ يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، بخاصةٍ مع تقدّم ترسانة الأسلحة المتطورة والفتاكة ناهيك بانتشار الأسلحة النووية. على سبيل المثال، إذا كان هناك دولتان نوويتان تتنازعان على أساس اختلال شديد التعقيد في توازن القوى، الأمر الذي يمكن، في ظروف معينة، أن يمنح إحداهما الوهم بالقدرة على كسب الحرب. يعني ذلك أنّه إذا أرادت دولة ما شنّ هجوم ذري مفاجئ ضد الأخرى، فقد تُلحق بها خسائر فادحة ودمارًا هائلًا، لكن الدولة البادئة بالهجوم لن تكون في وضعٍ يَسمح لها بالتأثير في القوة النووية للدولة الثانية إلى درجة منعها من الردّ، ما يعني أنّ هذه الأخيرة يمكن أن تُلحق بالأولى دمارًا بالقدر نفسه أو أكثر. وبالتالي، فإن هذا المأزق يعني، مع استمرار مسلسل الردّ والردّ المضاد، أنه في المراحل الأولى من الأعمال العدائية، يمكن أن يتعرض الطرفان لتدمير جذري يجعلهما غير قادرين على مواصلة الحرب.
من الردود المتبادلة إلى الحرب المفتوحة
قد تلجأ الأطراف المتنازعة إلى التقليل من حجم الضربات وتأثيرها ووصف أضرارها بالمحدودة، لتفادي الإحراج وإلزامية الردّ، في حين يعمد الطرف المهاجِم أي المبادِر، إلى الترويج أنّه حقق أهدافه مع الحذر من أن يشكّل الردّ ذريعة للطرف الآخر لشنّ هجوم أوسع وأشمل كخطوةٍ انتقامية. في هذا الإطار، وبعد إجراء تقييم دقيق لقياس فعالية الهجمات، يتمّ التركيز على مواءمة الأنشطة الإعلامية والعمليات العسكرية من خلال الدعاية وتسليط الضوء على نتائج الضربة (الردّ) وتأثيراتها على العدو، كل ذلك بالتوازي مع تفعيل الحركة الدبلوماسية.
في هذا السياق، وفي حلقة الرد والرد المضاد بين إيران والعدو الإسرائيلي، المتواصلة منذ نيسان الماضي، أشارت مصادر صحافية إلى أنّ واشنطن سعت من خلال اتصالاتها، إلى احتواء الرد الإسرائيلي وهدفت إلى الحدّ من تصاعد الردود العسكرية بين الطرفين. وبحسب مراقبين للوضع في المنطقة، فإنّ عدم استهداف منشآت نووية ونفطية إيرانية في الرد الإسرائيلي، يُعدّ نجاحًا لجهود واشنطن في احتواء هذا الرد. وأفادت المصادر أنّ الولايات المتحدة بذلت جهدًا استثنائيًا لضبط الردّ الإسرائيلي إلى درجة لا يسمح بانفلات الأمور إلى مواجهة أكبر في المنطقة. فاحتمال نشوب حرب مفتوحة يُقلق المجتمع الدولي، سواء من حيث الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن تسببها أو من آثارها المحتملة على الاقتصاد العالمي، لأنّه يخشى أن تُهاجَم منشآت النفط الإيرانية الأمر الذي له ارتدادات خطيرة جدًا على حركة الناقلات في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره أكثر من 20% من نفط العالم يوميًا.
إنّ تطورات دائرة الردود المتبادلة بين الجانبين تبقى خاضعة للمصالح المشتركة للدول المشاركة والمؤثرة في مجريات الأحداث التي تدور في المنطقة، بخاصةٍ أنّ إيران أعلنت احتفاظها بحق الردّ على هجوم فجر السبت 26 تشرين الأول 2024.
في الختام، إنّ عدم الخوض في لعبة الردّ والردّ المضاد، يمثل فرصة وضرورة لتجنّب مخاطر لا يمكن ضبطها أو قياسها. غير أنّ وقف حلقة الردود يتطلّب إخراجًا ملائمًا، وهذا الإخراج يستلزم بدوره وضعًا ميدانيًّا معيّنًا يكون مناسبًا لأطراف النزاع. فالهجمات من هنا أو من هناك تبقى بطبيعة الحال، محجّمة ومقيّدة ويمتثل إيقاعها بالدرجة الأولى للعبة توازن دقيقة قائمة على المصلحة الوطنية كي لا تنجرف الأمور إلى حرب مفتوحة لا يعرف أحد مداها. ففي العلاقات الدولية، لا يوجد عداوات ثابتة ولا صداقات ثابتة، إنّما مصالح ثابتة تحكُم مواقف الدول وسلوكياتها.